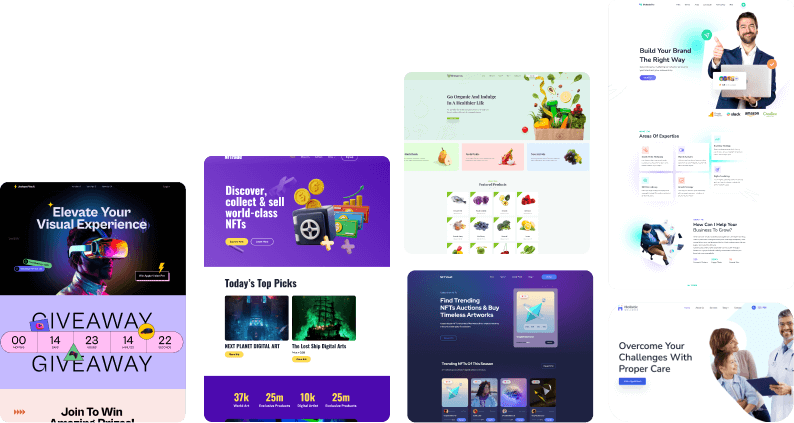من باريس إلى مصر
نحن الآن في باريس، وعلى وجه التحديد في الحي اللاتيني (Latin Quarter)، هذا المكان الذي أحبَّه عميدُ الأدب العربي طه حسين حتى قال عنه «ولكني أعشق في باريس مكانًا أعتقد أنه أقدس مكانٍ في العالم الحديث، وأنه الرأس المفكر لهذا العالم، لا أستثني منه بلدًا ولا مكانًا، وهو الحي اللاتيني.»[1] وبالتأكيد قد زاره رائدُ النهضة العربية رفاعة الطهطاوي، ومحرر المرأة قاسم أمين. فالمكان إذن هو باريس، مدينة الحب، والزمان هو عام 1830، وبصحبة رفاعة الطهطاوي، هذا الرجل الذي فتنته باريس وحال نسائها وقال:[2]
حتى النساء فإنهنََّ يسافرن وحدهنَّ، أو مع رجلٍ يتفق معهنَّ على السفر، وينفقن عليه مدة سفره معهنَّ؛ لأن النساء أيضًا متولِعات بحب المعارف والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها.
حُقَّ لرفاعة الطهطاوي أن يتعجب من تلك النساء المتولِعات بحب المعارف؛ فالنساء في بلادِنا في ذاك الوقت كنَّ جاهلات متخلفات، أو إن شئت قل: كن مُتجهِّلات أُريدَ لهن التخلف. فكأنما أُجبرن على الجهل جبرًا؛ ففي هذا الوقت الذي يصف فيه رفاعةُ حالَ نساء فرنسا المتولِعات بحب المعارف، لم تكن في مصر مدرسةٌ واحدة للبنات.
حيث أُنشئت أول مدرسة لتعليم البنات في مصر بعدما عاد رفاعة من باريس بما يزيد على الثلاثين عامًا، فلم يكن مقبولًا ولا مشهودًا في الثقافة العربية أن تنلْ المرأةُ حظًا من علمٍ أو معرفةٍ، وكان تعليم البنات «بدعة غير ممدوحة» كما وصفها المؤرخ إلياس الأيوبي في كتابه الشهير «تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل».
وأريد هنا أن أنقل لكم الصورةَ كاملةً كما وصفها الأيوبي نفسه، أنقلها بحروفه وكلماته، برسمها وشكلها، حيث كَتبَ يقول عن أول مدرسة أُنشئت للبنات في مصر:[3]
أما مدرسة السيوفية للبنات، فقد كانت الأولى من نوعها في العالم الإسلامي. أنشأتها الأميرة تشسما آفت زوجة (إسماعيل) الثالثة… على نفقتها الخاصة… وبشجاعة أدبية نادرة؛ لاعتبار العالم الإسلامي عملها هذا بدعة غير ممدوحة؛ لأن الرأي العام الإسلامي لم يكن راضيًا عنها؛ وكان وجوه القوم وكل من يظن في نفسه أنه ذو حيثية يأنف من إرسال بناته إليها لمخالفة ذلك للعادات المتبعة…
وقد كان ذلك الرأي العام شديد التأثير إلى درجة أن محمد علي أبى الموافقة على ما أشار به مجلس معارفه الأعلى من وجوب تعليم البنات، وإنشاء مدارس لهن، أسوة بمدارس الصبيان، واكتفى بتعليم بنات أسرته وجواريهنَّ. غير أن محمد علي لم يكن بالرجل الذي يهمل، بتاتًا، أمرًا يعتقده هامًّا ومفيدًا، لمجرد مخالفته للرأي العام… فلكي يهز جمود الأمة عن تربية بناتها، هزًّا يوقظها من نومها، أتاها من طريق سوي؛ وأنشأ بمساعدة كلوت بك، مدرسة قابلات؛ كانت كل تلميذاتها، في بادئ الأمر، عشر جواري حبشيات من سراي الخاصة.
كانت تلك أول مدرسة للبنات في العالم الإسلامي كله، ومن شدة سخط المجتمع على فكرة تعليم البنات، خشى محمد علي باشا (وهو الذي لا يخشى أحدًا) من سخط المجتمع المصري على فكرة إنشاء مدرسة لتعليم البنات، وعوضًا عن هذه «البدعة» أنشأ مدرسةً لتعليم البنات الولادة وبعض أساسيات الطب، بل حتى لم يملك محمد علي من الشجاعة أن يرسل إلى تلك المدراس فتياتٍ مصريات، فأدخل فيها في بادئ الأمر جاريات حبشيات تمهيدًا لفكرة تعليم البنات وإرسالهنَّ إلى المدارس لينهلنَ من العلم والمعرفة.
نادى رفاعة الطهطاوي بتعليم البنات، وكتب كتابًا شهيرًا بعنوان «المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين»، والذي يُعد من أكثر الكتب نهضةً وثوريةً في هذا الصدد، وربما من المثير للسخرية أن رفاعة الطهطاوي كان يَرُدُّ في كتابه على المعارضين لتعليم البنات، وكانت إحدى حجج المصريين في ذلك الوقت، أن البنات لو تعلمنَّ القراءة والكتابة لكتبن وأرسلن جواباتٍ ورسائلَ غرامية إلى الرجال[12]؛ وكأن تلكم الفتيات لا يملكن أقدامًا لتذهب بها إلى الرجال إن شئن، أو وكأنهن لا يملكن ألسنةً يتحدثن بها مع الرجال إن أردن، ولا عيونًا ينظرن بها إلى الرجال إن رغبن. فماذا نفعل: أنقطع أرجلهن كي لا يخرجن مع الرجال؟ أم نقطع ألسنتهن كي لا يتحدثن مع الرجال؟ أم نعمي عيونهن كي لا يظفرن بنظرة إلى الرجال؟ إن طريقة التفكير الساذجة والبلهاء تلك لا تنم إلا عن الجهل المدقع الذي كان يعيشه المجتمع؛ فعوضًا أن تزرع الأُسر في عقول أبنائها وبناتها الاحترام والفضيلة وحب العلم والرفعة به، عوضًا عن بذل هذا المجهود من قِبل المجتمع والأسرة في تربية الأولاد والبنات، كان الحل الأسهل والأكثر بلاهة وترسيخًا للجهل وفرارًا من المسؤلية هو منع البنات من تعلّم القراءة والكتابة بالكلية.
وعلى الرغم من أن رفاعة الطهطاوي كتب كتابه هذا عام 1837، وأن أول مدرسة لتعليم البنات أُنشئت عام 1873 أي بعد أكثر من ثلاثة عقود، لكن يبدو أن تعليم البنات — حتى بعد مناداة رفاعة، وبعد إنشاء المدرسة — لم يترسخ كقاعدة مجتمعية وكأمر مقبول لدى المجتمع المصري.
وعَودٌ إلى باريس التي أقام بها رفاعة الطهطاوي من قبل، فقد أقام بها قاسم أمين بعد ذلك، وفتنته كما فتنت رفاعة الطهطاوي، حيث نجد قاسم أمين بعد نحو ثلاثة عقود أخرى من إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات ينادي مرارًا وتكرارًا بتعليم البنات، بل كان يرجو أن تتعلم البنات فقط المرحلة الابتدائية كما جاء في كتابه «تحرير المرأة»، ويقول:[4]
ففي رأيي أن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها إلَّا بعد تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقليَّة والأدبيَّة. فيجب أن نتعلَّم كل ما ينبغي أن يتعلَّمه الرجل من التعليم الابتدائي — على الأقل — حتى يكون لها إلمام بمبادئ العلوم يسمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها منها، وإتقانه بالاشتغال به متى شاءت.
فإذا تعلَّمت المرأة القراءة والكتابة، واطلعت على أصول الحقائق العلميَّة، وعرفت مواقع البلاد، وأجالت النظر في تاريخ الأمم، ووقفت على شيء من علم الهيئة والعلوم الطبيعيَّة، وكانت حياة ذلك كله في نفسها عرفانها العقائد والآداب الدينية استعدَّ عقلها لقبول الآراء السليمة، وطرح الخرافات والأباطيل التي تفتك الآن بعقول النساء.
أُنشئت الجامعة المصرية — جامعة القاهرة الآن — عام 1908، واستمرت الدراسة بها عشرين سنة كاملة دون أن تكون بها بنتٌ مصريةٌ واحدة. حتى جاءت سهير القلماوي، تلك الفتاة المصرية التي حصلت على شهادة البكالوريا — الشهادة الثانوية — من كلية البنات بالجامعة الأمريكية، أخذها والدُها — الطبيب الجراح ذو الأصول الكردية والمؤمن بأهمية تعليم البنات — لتقديم أوراقها لكلية الطب بجامعة القاهرة لإعجابها الكبير بأبيها ورغبتها فى أن تكون مثله. لكن جامعة القاهرة رفضت أوراقَها بحجة أن كليةَ الطب لا تقبل بتعليم البنات، فذهب أبوها إلى عميد كلية الآداب د. طه حسين ليتوسط له، فأقنعه العميدُ أن تتقدم بأوراقها إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية، بيد أن جامعة القاهرة رفضت أوراقها للمرة الثانية. حتى استطاع طه حسين إقناع رئيس الجامعة الأستاذ أحمد لطفى السيد — الذي كان هو الآخر يدعم حقَ البنات في التعليم —، استطاع إقناعه بحيلة ذكية ذكرتها زوجة العميد، السيدة سوزان طه حسين في كتابها «معك» وتقول:[5]
من بين المصاعب التي أُثِيرَتْ في وجه دخول الفتيات للجامعة، كانت هناك صعوبة تؤلم لطفي كثيرًا. فقد كان الدستور يعطي لكل مصريٍّ الحقَّ في دخول الجامعة، ولكن اللفظ الذي ورد في النص كان مذكَّرًا؛ ومن ثَمَّ، فهو لا يعني النساء. لكنَّ طه دفع الأمر إلى الأمام شأنه دومًا في مثل هذه الحالات قائلًا: «ألا تعني كلمة «المصريون» مجموعَ سكان مصر؟!» فأجاب لطفي: «دون أي شك.» فقال طه: «إذن، ألا يعني ذلك النساء أيضًا؟!»
كانت تلك إذن الحيلة التي افتعلها طه حسين، حيث استخدم كلمة «المصريون» باللفظ المذكر لتشمل الرجالَ والنساءَ معًا، ولكن إذا كان التحايل على لفظِ الدستور بجعلِه للرجال والنساء قد يُجدي نفعًا لصالح طه حسين، فما عساه فاعلًا أمام الرأي العام في مصر الذي يرفض دخول البناتِ الجامعةَ؟
 كانت تلك معضلة كبيرة تواجه كلاً من أحمد لطفي السيد وطه حسين، حتى توصلا إلى أن الحل الأنسب هو إخفاء هذا الأمر عن الصحافة وعن الناس والحكومة، حتى تَدخُل البناتُ الجامعاتِ، ويمضي على دخولهن فترةٌ من الزمن، وبهذا يصبح الأمرُ واقعًا لا مفرَ منه ولا مخرج. وبالفعل، دخلت سهير القلماوي الجامعةَ، وأصبحت أول طالبة مصرية في التاريخ تلتحق بالجامعة، وتَبِعتها فتياتٌ أخريات وكان عددهُن 17 طالبة، وقدم إليها عميد الأدب العربي كل دعمه ومساندته، واكتنفها برعايته وملاحظته، حتى أنه أمر بحراسةٍ خاصةٍ لها تصحبها يوميًا من الجامعة وإليها، مخافة أن يفشل مسعاه في تعليم البنات أو أن تبوء هذه التجربة الواعدة والأولى من نوعها بالفشل.[6]
كانت تلك معضلة كبيرة تواجه كلاً من أحمد لطفي السيد وطه حسين، حتى توصلا إلى أن الحل الأنسب هو إخفاء هذا الأمر عن الصحافة وعن الناس والحكومة، حتى تَدخُل البناتُ الجامعاتِ، ويمضي على دخولهن فترةٌ من الزمن، وبهذا يصبح الأمرُ واقعًا لا مفرَ منه ولا مخرج. وبالفعل، دخلت سهير القلماوي الجامعةَ، وأصبحت أول طالبة مصرية في التاريخ تلتحق بالجامعة، وتَبِعتها فتياتٌ أخريات وكان عددهُن 17 طالبة، وقدم إليها عميد الأدب العربي كل دعمه ومساندته، واكتنفها برعايته وملاحظته، حتى أنه أمر بحراسةٍ خاصةٍ لها تصحبها يوميًا من الجامعة وإليها، مخافة أن يفشل مسعاه في تعليم البنات أو أن تبوء هذه التجربة الواعدة والأولى من نوعها بالفشل.[6]
وعلى الرغم من حدوث ما كان يتوقعه طه حسين ولطفي السيد من موجة النقد الحاد لدخول البنات الجامعة ودراستهم يدًا بيد مثل الشباب تمامًا، أُثيرت موجة من النقد اللاذع إليهما، وقدم النائب عبد الحميد سعيد استجوابًا في فبراير 1932 لوزير المعارف، لنشر جريدة الأهرام صورة للدكتور طه حسين وحوله لفيف من الطلبة والطالبات، معبرًا عن دهشته لهذه الصورة إذ كيف يجتمع طه حسين بالشباب والبنات معًا، بعد أن صَرَّحَ الوزير بأنه «لا يسمح بالاختلاط في معاهد التعليم»، وعَدَّ النائب نَشْر الصورة دليلًا على «عدم احترام الشعور الديني والآداب القومية»، ورَدَّ الوزير على الاستجواب، بأن الصورة في اجتماعٍ بنادي طلبة الجامعة، وأن الجامعة نبهت على الطالبات بعدم دخول هذا النادي، وعلى ذلك فلن يتكرر ما حدث». وقد أورد الدكتور رؤوف عباس هذه الوقائع في كتابه «تاريخ جامعة القاهرة» وقال:[10]
أثار بعض الأزهريين وبعض شباب الإخوان قضية الاختلاط داخل الجامعة، فتقدم بعض الطلبة بمذكرتين إلى رئيس الجامعة وعميدي الكليات يطالبون فيها بتخصيص جانبٍ من المناهج الثقافية الدينية في جميع الكليات، وبتوحيد زي الطلبة والطالبات وفصلهنَّ عن الطلبة، وتخصيص دراسة خاصة بهن. ثم نشرت «الأهرام» حديثًا لشيخ الأزهر عبّر فيه عن سروره بالمذكرة التي قدمها الطلاب، وكان لهذا الحديث أثره في إثارة طلبة الأزهر، فقاموا بمظاهرات تأييد للمطالبين بعدم الاختلاط بتشجيع من شيوخ كليات الأزهر».
تصدى الدكتور طه حسين لهذه الدعوة، ففي حديث لجريدة «المصري»، قال إنه لا يعرف في القرآن ولا في السنة نصًا يُحرِّم على الفتيات والفتيان أن يجتمعن في حلقةٍ من حلقات الدرس حول أستاذ يعلمهم العلم والأدب والفن، وإن الجامعة لم تُحْدِث حدثًا، ولم تخرج على نصٍّ من نصوص الدين. وأعلن أن الجامعيين لا يتلقون أمرًا من معهد آخر مهما كان شأنه، وليحترم الأزهرُ استقلالَ الجامعة كما تحترم الجامعةُ استقلالَ الأزهر، وطالب الأزهريين الذين نادوا بتعليم الفتياتِ الدينَ، طالبهم بأن يتركوا مسألة الدين للطلبة أنفسهم؛ فليس بين طلاب الجامعة قاصرًا ولا عاجزًا عن تثقيف نفسه في الدين، والكليات ليست مدارس ابتدائية ولا ثانوية، وإنما طلاب الكليات راشدون يستطيعون أن يتعلموا الدين إن أرادوا»
ولكن للأسف بعد يومين اثنين، تم فصل الدكتور طه حسين من الجامعة، وعاد إلى بيته بلا أي وظيفة ولا أي مال، خسر طه حسين كل شيء، إلا نفسه وكرامته والحق الذي يدافع عنه. وقد جسّد محمود عوض فى كتابه «أفكار ضد الرصاص» حالة طه حسين وقال: فى هذا اليوم خرج طه حسين مطرودًا من العمل بالحكومة، ذاهبًا إلى منزله، وفي المنزل كان الجميع في انتظاره، زوجته، وأولاده، ولكنّ ضيفًا آخر وصل منذ دقائق، ضيف ثقيل الظل هو خطاب من بنك مصر، يضم إخطارًا قصيرًا بأنه أصبح مدينًا للبنك بثمانية جنيهات، يجب عليه دفعها فورًا، وبحث طه حسين في جيبه فلم يجد قرشًا واحدًا.
لكن العميد الذي لا يوقف قوتَه أيُ شيء ظلّ — رغم هذا كله — متصديًا بصدر عارٍ وقلبٍ جسورٍ على تلك التظاهرات والمذكرات والإدانات، كما كان لتفوق طالبات الجامعة أثرٌ بالغٌ وجوابٌ مُخرِسٌ لكل هذه الأصوات، ومضت الحال على ذلك، وتخرجت الطالبات في الجامعة، ولم يعبأ أحدٌ بنقد الناقدين، وأظهرت البنات تفوقًا رهيبًا ومجهودًا فريدًا، حتى تخرجت سهير القلماوي وعُيّنَت معيدةً بكلية الآداب، فكما أنها كانت أول أنثى تلتحق بالجامعة، فهي أول أنثى تعمل بها أيضًا.
وظل الأزهر الذي عارض وجود الفتيات في جامعة القاهرة لا يقبل بدراسة البنات لمدة ٤٠ سنةً بعد ذلك، حتى جاء الدكتور محمود شلتوت عام 1962 وأنشأ أول معهدٍ أزهريًّ للبنات، فإذا كانت جامعة القاهرة قد قبلت بدراسة البنات بها بعد عشرين سنة من إنشائها، فإن جامعة الأزهر سمحت بدراسة الفتيات بها بعد نحو ألف سنةٍ من إنشائها، فلا عجب إذًا أن لا نسمع بعالمة واحدة أو فقيهة واحدة تخرجت في الأزهر طيلة عشرة قرون من التدريس بالجامعة.

لم يتوقف دعم طه حسين لسهير القلماوي عند إدخالها الجامعة مع معارضة الأزهر والدستور والدولة ومجلس النواب والمجتمع والعُرف السائد والعادات القائمة لتلك الخطوة، بل حتى — بعد فصل طه حسين من الجامعة — ذهب معها يوم امتحان الليسانس وكان عضوًا في لجنة الامتحان، متحديًا بذلك قرار رئيس الوزراء شخصيًا. بل حثها لاستكمال مسيرتها التعليمية وأصرّ أن تبدأ بدراسة الماجستير على يد الأستاذ أحمد أمين، وشارك العميدُ في لجنة امتحانها في الماجستير كذلك. ثم بعدما أنهت الماجستير أخذ العميدُ على يديها لتستكمل الدكتوراه، ومن جميل ولطيف ما صنع، أنها كانت ستناقش الدكتوراه في شهر فبراير عام 1941، إلا أنّ العميد أمرها أن تتأخر ثلاثة أشهر لتناقش رسالتها في اليوم الخامس من شهر مايو، لأن العميد ناقش رسالته في السوربون في هذا اليوم، وأراد لتلميذته أن تكون مثله وأن تناقش سهير القلماوي رسالتَها للدكتوراه في نفس اليوم الذي ناقش فيه العميدُ رسالتَه.
أراد العميد أن تعمل تلميذتُه معيدةً في الجامعة، إلا أن والدة سهير القلماوي التي كان يسميها العميد «الدولة العثمانية» نظرًا لشدتها وصرامتها في تعاملها مع ابنتها، عارضت الأمُ تعيين ابنتها وعملها في الحكومة أشد المعارضة ورفضته أشد الرفض، فكانت ترى عمل ابنتها عارًا سيلحق بها، لكن العميد الذي واجه رئيس الوزراء والدستور والمجتمع المصري كله، أيعجز عن مواجهة والدة سهير القلماوي؟ أقنع العميدُ والدةَ الفتاة أن تترك ابنتها تعمل في الجامعة، وكان ما أراد العميد، وكانت سهير القلماوي أول فتاة تُعين في الجامعة في التاريخ المصري. ثم أراد العميد أن يرسل تلميذته في بعثة إلى فرنسا، إلا أن أمها عارضت الأمر كذلك، ومع ضغط العميد، وافقت الأم على شرط واحد، أن تذهب سهير إلى فرنسا لكن بصحبة أسرة مسافرة. وحقق العميدُ شرطَ الأم وسافرت سهير إلى فرنسا وأتمت بعثتها هناك. وما إن أتى قضاء الله وأمره وتُوفي والد سهير القلماوي، وأصابها الألم والحزن الشديدين، كان العميدُ بجوارها داعمًا وملاحقًا وملحًا عليها أن تكتب أول كتاب لها وتنشره، وكتبت سهيرُ كتابَها الأول بإلحاحٍ من العميد، وكان فرحُها بنشر كتابها مواسيًا لها ومخففًا عليها مرارة فقد أبيها. ويوم ماتت أمها أرسل إليها العميد رسالةً وهو في أيطاليا، قالت عنها سهير القلماوي:
“أرسلتَ إليّ من قريتك في إيطاليا رسالةً مفعمةً بالحنان والإشفاق ما زلت أقرؤها مرات كلما عصفت بي الهموم فأتعزى. كنتَ لي أبًا حنونًا وجدارًا ضخمًا أستند إليه كلما احتجت إلى سند أو عون أو عزاء”.
وإن كنت قد أطلتُ على القارئ في مقالي هذا، إلا أن هناك الكثير والكثير لم أذكره بعد، فأول ما تقدم شاب لخطبة سهير كان العميد هو الوجهة الأولى لها لتستشيره وتعمل برأيه، وما إن تمّ الزواج، كان العميد شاهدًا على عقد زواجهما، ولا تزال إمضاؤه في عقد زواجها. أقول: وإن كنت قد أطلت على القارئ فمن المستحيل أن أنهي هذه الفقرة دون أن أنقل كلمات كتبتها سهير القلماوي بقلمها عن العميد، شاء القارئ ذلك أم أبى، رضي عن طول المقال أم سخط، تقول سهير:
“وفي كتابِك «مع أبي العلاء في سجنه» تقول إنك تتعرض لحياة الكُتّاب والشعراء بالدرس، ولأعمالهم بالنقد، لا تحفل بأحد منهم حيًا كان أو ميتًا إذا سخط على ما كتبت أو غضب مما قلت. ولكن ما هكذا أبو العلاء المعري بالنسبة إليك. إنه لا يعنيك أن يرضى المتنبي أو يغضب، وما يعنيك أن يلقاك الطائيان — أو تمام والبُحتري — بالرضا أو بالغضب في هذه الحياة أو تلك، لكنك تكره أن تقسوَ على أبي العلاء راضيًا أو كارهًا مخافةَ أن تلقاه فإذا هو متأذٍ بهذه القسوة؛ لأنك تحبه كما قلت. وهذا موقفي الآن منك. لا أدري أساخطًا ألقاك على هذا الكتاب أم راضيًا عنه. وإني لأشفق على نفسي أن تكون غير راضٍ أو تكون كلمة “لكن” تحمل بعدها ما يُشعربي بالذنب…
مَن لي بأن أسمع منك “لكن” بكل هولها الذي كنتُ أخشاه! مَن لي بأن أرى ابتسامتك المُشجعة التي تحفزني على أن أكتب عنك ما أشعرُ أنه ربما أرضاك. وما كتابي هذا الذي أقدمه إليك اليوم إلا دمعة وفاء.
فهل يشفع لي هذا عندك يا أبي…. وأستاذي!”[11]
من مصر إلى بريطانيا
كان هذا ما حدث مع سهير القلماوي التي أرادت الالتحاق بكلية الطب في جامعة القاهرة، فرفضتها الجامعة، فتقدمت مرة أخرى، فرفضتها ثانيةً، حتى تَدَخَّل العميدُ وسنَّ سُنَّةً حسنةً لا تزال آثارُها باقيةً حتى يوم الناس هذا، ومن سهير القلماوي التي رفضتها كلية الطب بجامعة القاهرة، ومن باريس التي أثارت شرارة رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وطه حسين، إلى صوفيا جيكس بليك (Sophia Jex-Blake) بكلية الطب بجامعة إدنبرة.
وُلدت صوفيا في إنجلترا عام 1840، تلقت تعليمًا منزليًا، ثم التحقت بعدة مدارس خاصة حتى درست في مدرسة كوينز كوليدج (Queen’s College, London) في لندن، تلقت معارضةً من أسرتها بسبب تعليمها، وقال لها أبواها إنها لن تحصل على مليمٍ واحدٍ في الحياة بسبب سعيها للتعلم، إلا أنها أبدت في دراستها تفوقًا بارعًا حتى عرضت المدرسة عليها أن تعمل مُدَرِّسَةً للرياضيات بها.[7]
سافرت صوفيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتعلم أكثر عن تعليم البنات، وزارت مدارس عديدة، وكان حلمها أن تكون طبيبة بارعة. وبالفعل، تقدمت إلى جامعة هارفارد لتدرس الطب بها، حتى وصل لها خطابٌ بعد أيام من جامعة هارفارد يقول:
نعتذر لكم، ولكن لا يوجد أي بند في قوانين الجامعة يسمح للنساء بالدراسة في أي قسم من أقسام جامعة هارفارد.
لم تيأس صوفيا من تثبيط أبويها، ولا من رفض جامعة هارفارد لدراسة البنات بها، وأرادت في العام التالي الالتحاق بكلية الطب التي أسستها الطبيبة الإنجليزية إليزابيث بلاكويل (Elizabeth Blackwell) في نيويورك، حيث كانت إليزابيث أول امرأة بريطانية في التاريخ تحصل على شهادة جامعية في الطب من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نظرًا لوفاة والدها فقد عادت صوفيا إلى إنجلترا لتكون بجوار والدتها.

وحاولت للمرة الثالثة التقديم لدراسة الطب، فتقدمت إلى كلية الطب بجامعة إدنبرة في بريطانيا، قبلتها كلية الطب من باب الشفقة، ولكن الجامعة أصدرت قرارًا برفض قبولها قائلة إنها لا تستطيع أن تجهز كل المستلزمات المطلوبة لدراسة الطب فقط لأجل سيدة واحدة.
توجهت صوفيا إلى واحدة من أشهر الصحف البريطانية وهي جريدة “The Scotsman” مطالبةً باقي الفتيات البريطانيات بدعمها والتقديم معها لدراسة الطب في جامعة إدنبرة. ولحسن الحظ فلقد آتى هذا الإعلان ثماره ولحقت بها ست فتيات أخريات.
اجتازت الطالباتُ السبع امتحانَ القبول في جامعة إدنبرة، ومن بين 152 طالبٍ تقدموا للامتحان، حصدت 4 فتيات منهم المراكز السبع الأُوَلى، متقدمات على 150 من الطلاب الذكور من نظائرهم. ولكن كانت لوائح الجامعة تنص على أنه مسموح للأساتذة بالتدريس للفتيات، ولكن ليس مطلوبًا منهم ولا فرضًا عليهم ولا من واجباتهم التدريس للنساء، كما زادت الجامعة من الرسوم الدراسية لتلك الفتيات أكثر من الأولاد، وكانت هذه بداية المعاناة.
وفي أول امتحان للطالبات السبع في الجامعة، لم يجتزن جميعهن الامتحانات المقررة فحسب، بل حصلت 4 فتيات منهن على امتيازٍ مع مرتبة الشرف، بل إن طالبةً منهن وهي إديث بيشي (Edith Pechey)، حصلت على المرتبة الأولى على جميع زملائها، وهو ما يؤهلها إلى الحصول على منحة دراسية تسمى منحة الأمل (Hope Scholarship)، وهي منحة تقدمها جامعة إدنبرة للطالب الذي يحصد المركز الأول.
ولكن نظرًا لأن المنحة ستحصل عليها فتاة، فقد رفضت الجامعةُ إعطاءَ الطالبة إديث منحتَها، وأعطتها للطلاب الذكور، على الرغم من أنهم كانوا أقل منها مرتبةً وتفوقًا، لا لشيءٍ، إلا لأنها أنثى.
كانت الجامعة منقسمة، ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ لالتحاق الفتيات بها، خاصةً وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تلتحق بها الفتيات بأي جامعة بريطانية. وقد صرح البروفيسور روبرت كريستسون (Robert Christison) قائلًا: إن الفتيات التي تسعى إلى التعليم والحصول على درجة في الطب هنَّ «منحلات ومنحرفات». ونتيجة الهجوم الشديد عليهنَّ، تراجع بعض الأساتذة المؤيدين لتعليم النساء عن دعمهنَّ، وبدأ الطلاب في الجلوس على مقاعد الفتيات في المحاضرات، وبدأوا في السخرية والضحك والعِواء كلما دخلت واحدة منهنَّ قاعة المحاضرات.
وبدأ الناس بشتمهنَّ في الأماكن العامة كلما مررن بطريقٍ، ونُزِعَت اللوحة المكتوب عليها اسم «صوفيا» من على باب غرفتها 5 مرات. وقالت الطالبة إديث بيشي (الحاصلة على المركز الأول كما ذكرنا) إنها كانت تُنادى بأقبح العبارات والألفاظ حتى نوديت يومًا بأنها «عاهرة»؛ ولذلك قررت الفتيات نتيجة هذا كله عدم السير وحدهن منفردات في الجامعة، على أن يسرن مُجتمعاتٍ مع بعضهن بعضًا.
وزادت الأمور حدة وبلغت المضايقات أقصاها في إحدى محاضرات التشريح يوم 18 نوفمبر 1870، حيث اجتمع حشدٌ من الناس، ما يقرب من 200 شخصٍ، من بينهم طلاب في الجامعة، واستمرت المضايقات لهن، والتحرش بهن، وسبهن وشتمهن، حتى أن الناس ضربوهن على وجوهِهن، بل لطّخوا وجوهَهن بالطين.[8]
إلا أن مجموعة من الطلاب المعارضين لهذه الطريقة البشعة، أدخلوا البنات قاعة المحاضرات، وأصروا على حمايتهن، وكانوا يأخذونهن يوميًا ولمدة أسابيع من البيت إلى الجامعة ذهابًا وإيابًا حتى لا يصيبهن مكروه.
ورغم هذا كله، فقد رُفعت دعوى قضائية ضد تلك الفتيات، وحَكمت المحكمة بإدانتهن، وغَرمتهُنَّ جنيهًا إسترلينيًا لكل واحدة؛ لأنهن «أخللن بالسِلمِ العام».
تصاعدت حدة الاعتراضات على وجود الفتيات في الجامعة، حتى انتهى الأمر بقرارٍ من المحكمة يمنع إعطاء أي درجة علمية للنساء، حتى أن القاضي قال في قراره: إن النساء لا يجب عليهن أن يتعلمن مطلقًا. وكانت هناك آراء بين الأساتذة تقول: إن الجامعة ما أُنشئت إلا للرجال فقط.

طُردت الفتيات من الجامعة، ولكن صوفيا لم تيأس، فحاولت دراسة الطب للمرة الرابعة واتجهت إلى سويسرا لتدرس في جامعة بيرن، وحصلت على درجتها الجامعية، بل وقررت أن تعمل على إنشاء أول مؤسسة لتعليم الطب للنساء، فأنشأت كلية الطب بلندن للنساء (London School of Medicine for Women) كما أنشأت كلية أخرى أيضًا وهي كلية الطب بإدنبرة للنساء (Edinburgh School of Medicine for Women).
ونظرًا لهذه الجدالات الواسعة، وبفضل معركتها الضارية، وصبرها الجميل، تغيّر القانون البريطاني في النهاية وصار مسموحًا للنساء الالتحاق بالجامعات والحصول على درجات علمية منها.
وفي العام الماضي، وبعد 150 سنة، قررت جامعة إدنبرة تكريم تلك الفتيات — بعد موتهِن — وحصلنَ على شهادات تخرج من كلية الطب بجامعة إدنبرة التي حاولنَ وحاولنَ الدراسة والتخرج فيها، ولاقينَ في ذلك أشد أنواع الاضطهاد حتى ضُرِبنَ ورُمينَ بالطينِ، واستلمت فتيات طبيبات في الجامعة شهادات التخرج تمثيلًا للفتيات السبع اللواتي قضينَ نحوبهنَّ.[9]
خاتمة
ما بين سهير القلماوي التي أرادت دراسة الطب ورفضتها جامعة القاهرة، وما بين صوفيا التي أرادت دراسة الطب فرفضتها جامعة إدنبرة، حتى حصلت على شهادة التخرج بعد وفاتها بـ 150 عامٍ. ما بين هذه المِصرية، وتلك البريطانية، قصة كفاح للنساء من أجل أن يكون لهن موضع قدمٍ في الحياة وفي العلم وفي الجامعة.
ما بين قصةٍ مصرية — لحسن الحظ — كان عميدُ الأدب العربي داعمًا لها، ومؤيدًا لها، ومُعيِّنًا حراسةً شخصية لسهير القلماوي حتى تنجح، وقصةٍ أخرى بريطانية، لكن — لسوء الحظ — لم يتوفر لصوفيا شخصًا كطه حسين ليكون من خلفها داعمًا، ولأجلها مناضلًا ولتعليمها مدافعًا ومحاربًا.
ما بين هذه وتلك، قصة كفاح، كانت المنتصرة فيها هي المرأة، وكان المنتصر فيها هو العلم، وليتبين لنا صدق عبارة رفاعة الطهطاوي حين قال: «لأن النساء أيضًا متولِّعات بحب المعارف والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها» ليت رفاعة الطهطاوي حيًّا ليرى أن هذا التَّوَلُّع بحب المعارف هو ما جعل المرأة تحصل على شهادة التخرج في كلية الطب كما أرادت، وليُكتب لها الانتصار في معركتها الدامية حتى بعد وفاتها بقرنٍ ونصف.