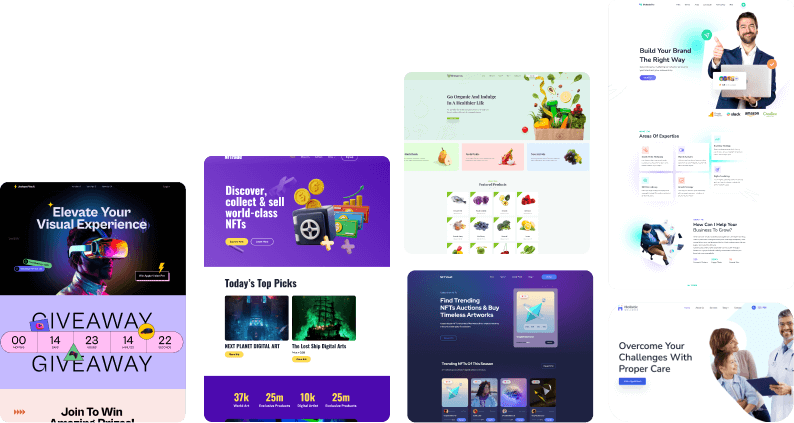يعتقد العديد من العلماء أن هناك طريقة موحدة وشاملة لجميع التخصصات يجب اتباعها لمن أراد أن يشتغل بالعلم بشكل جيد ومنضبط. ومع ذلك، فإن الأمثلة المعطاة لتلك الطريقة التي يجب اتباعها تكون مستمدة دائمًا من العلوم التجريبية الكلاسيكية وحدها. ونظرًا لعدم إمكان اختبار الفرضيات التاريخية في المختبر، يُقال أحيانًا إن البحث التاريخي أدنى شأنًا وأقل مرتبةً من البحث التجريبي. ونحن نوضح في هذا المقال – وباستخدام أمثلة من مجالات تاريخية متنوعة – أن مثل هذه الادعاءات مضللة وباطلة. حيث يعتمد التفوق المشهور للأبحاث التجريبية على تفسيرات للمنهجية العلمية (كالاستقراء أو القابلية للتكذيب) والتي تكون فيها هذه التفسيرات غير منضبطة بتاتًا، سواءً من الناحية المنطقية أو من حيث حديثها ونظرتها للممارسات الفعلية التي يقوم بها العلماء. ثانيًا، على الرغم من وجود اختلافات جوهرية في المنهجية بين العلماء التجريبيين وعلماء التاريخ، إلا أن هذه الاختلافات مرتبطة بسمة أساسية في الطبيعة نفسها، ألا وهي عدم التماثل الزمني للحتمية ما بين الماضي والمستقبل. ونتيجة لذلك، فإن الادعاء بأن العلوم التاريخية أقل شأنًا من الناحية المنهجية، للعلوم التجريبية لا يمكن أن يقف على ساق.
المقدمة:
عادةً ما يتم تعريف المناهج التجريبية على أنها تلك التي تقع داخل إطار اختبار الفرضيات. حتى أن المنهجية العلمية التي يتم شرحها في الكتب المدرسية، دائمًا ما يتم تقديمها للطلاب على أنها تقوم على هذا الأساس الذي هو اختبار الفرضيات وفحصها. لكن نظرًا لحقيقة أنه لا يمكن اختبار وفحص جميع الفرضيات العلمية داخل المعمل، كالفرضيّات التاريخية مثلًا، فإن قلنا أن حدثًا ما قد حدث في الماضي وانتهى، وذلك الحدث هو المتسبب في حدوث ظاهرة نراها الآن في وقتنا الحاضر، لهو مثال جيد على تلك الفرضيات العلمية التي لا يمكن تجريبها في المعمل. وعلى الرغم من أن تلك الفرضيات العلمية عادةً ما تكون مرتبطة بمجالات وتخصصات علمية مثل علوم الأثار وعلوم الحفريات، إلا أن تلك الفرضيات موجودة بكثرة في مجالات أخرى مثل الجيولوجيا وعلوم الأرض، وعلم الفلك، والفيزياء الكونية. ومن الأمثلة على تلك الفرضيات هو انزياح الطبقات التكتونية للأرض، أو النيزك الذي اصطدم بالأرض وتسبب في انقراض الديناصورات، أو الانفجار العظيم الذي يفسر بداية الكون، أو حتى بعض الفرضيات الحديثة مثل أن هناك كواكب تدور حول نجوم بعيدة جدًا. الظاهر أن القاسم المشترك في كل هذه الفرضيات جميعًا هو أنها تفسر ظواهر نراها الآن عن طريق فرض أسبابها التي حدثت في الماضي، فشكل الشاطئ الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية والشاطئ الغربي لقارة إفريقية اللتان ستلتحمان بشكل كامل إذا ما وضعا بجوار بعضهما، تفسره فرضية الانزياح القاري. التي مفادها أنهما كانتا قارة واحدة في الماضي وانزاحت كل منهما عن الأخرى. أو عنصر الإيراديوم النادر الوجود على الأرض، والموجود في بعض النيازك والكويكبات حين نجده في نهاية العصر الطباشيري، وهي نفس الفترة التي انقرضت فيها الديناصورات، لهي ظاهرة تفسرها فرضية النيزك الذي اصطدم بالأرض وتسبب في انقراض تلك الكائنات. أو إشعاع الخلفية الكونية المتساوي في درجة حرارته في جميع الجهات، لهي ظاهرة تفسرها نظرية الانفجار العظيم. أو تلك الحركة المتذبذبة لبعض النجوم البعيدة، لهي ظاهرة تفسرها وجود كوكب تؤثر جاذبيته على هذا النجم. وحتى إذا تم استخدام المحاكاة بأجهزة الكمبيوتر، فهي لا تغير من حقيقة أن تلك الفرضيات هي فرضيات تاريخية غير قابلة للتجربة المعملية.

على الرغم من انتشار تلك الفكرة التي مفادها أن العالِم الجيد لا بد أن يتبع طريقة محددة في اختبار فرضياته، إلا أن الناظر المتفحص في طريقة عمل العلماء في المجالات التجريبية أو المجالات التاريخية، سيجد أن الأمر ليس كما يبدو وليس كما هو شائع. فطريقة أداء البحث العلمي التجريبي هي الإتيان بفرضيات وتنبؤات، ومن ثمّ يتم اختبارها والتأكد منها داخل مختبر أو معمل مُحكم الضبط والإعداد. لكن على العكس من ذلك، فإن طريقة أداء البحث العلمي التاريخي هي مشاهدة ظواهر ومن ثمّ تفسير تلك الظواهر الحالية عن طريق فرض أسباب وحوادث حدثت في الماضي، دون القدرة على تكرار تلك الأسباب أو اختبارها داخل المعمل. هذا الخلاف جوهري بين ممارسة العلوم التجريبية والعلوم التاريخية أدركه العديد من العلماء التجريبيين، معتبرين طريقة عملهم وبحثهم هي الطريقة العلمية الصحيحة، إذ هم يعيدون ويتأكدون من فرضياتهم داخل المعمل، بينما الطريقة العلمية التاريخية لا يمكن التأكد منها ولا تكرارها ولا تخطيأها، بل إن ما يأتي به العلماء التاريخيون ليس إلا مجرد قصص وحكايات يؤكدون بها فرضياتهم. (بل إنها ليست إلا كقصص الأطفال الخيالية التي يكتبها الكاتب الإنجليزي «روديارد كيبلينج Rudyard Kipling»، اقرأ إن شئت قصته عن كيف اكتسبت النمور تلك البقع السوداء التي على جسدها). وإن أردت دليلًا على ذلك، فانظر إلى العدد الهائل من الفيزيائيين والكيميائيين الذين يعارضون ويهاجمون نظرية التطور الجديدة. وكمثال على ذلك، فإن واحدًا من أكثر الانتقادات حدة للعلوم التاريخية أتى من البروفيسور الإنجليزي «هنري جي Henry Gee» المحرر في مجلة نيتشر العالمية، الذي كتب مهاجمًا لهذه الحالة التي عليها تلك العلوم المتعلقة بفرضيات لأحداث تاريخية طاعنة في القدم وقال:
«هذه الفرضيات لا يمكن أبدًا أن يتم اختبارها وتجربتها، وبالتالي فهي فرضيات غير علمية من أساسها، إذ أن العلم لا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن يكون تاريخيًا.»
هدف هذا المقال هو بيان وتوضيح لماذا لا تقلّ العلوم التاريخية عن العلوم التجريبية عندما تأتي القضية إلى اختبار الفرضيات. سنجد أولًا أن اعتراض «هنري جي» قائم على فهم خاطئ منتشر عن العلم التجريبي ومنهجه وممارسته بشكل عام. ثانيًا، ذلك الاختلاف الموجود بالفعل بين منهجية ممارسة العلم التجريبي والعلم التاريخي موجود كصفة وخاصية في الطبيعة نفسها بشكل أساسي، ألا وهي عدم التماثل الحتمي بين الأحداث الحاضرة والماضية من جهة، وبين الأحداث الحاضرة والمستقبلية من جهة أخرى. وبقدر ما يحاول كل منهما اختبار الطبيعة واستنطاقها لإخراج ما تحمله وتخفيه من معلومات محاولين الخروج بفرضيات جديدة وفهم أكثر دقة للعالم المحيط بنا، فإن المعلومات ذاتها التي تعطيها لنا الطبيعة تختلف في خصائصها وسماتها، وبالتالي ستختلف مناهج فهمها واستخراجها. وعليه، فلا يمكن لممارسة منهما (أي التاريخية والتجريبية) أن تدعي أنها أكثر مصداقية وعقلانية وعلمية من الأخرى.
المنهجية العلمية:
الفرضيات التي يتم اختبارها في المنهج التجريبي الكلاسيكي تكون فرضيات ذات طابع عام، فمثلًا إن قلنا أن “النحاس يتمدد بالحرارة” فتلك عبارة تتحدث عن النحاس بشكل عام ومطلق. يبدأ عمل العلماء من الإتيان بجملة شرطية (T) يتم استخراجها من الفرضية (H). وهو ما يعني أن الشرط (T) لا بد أن يحدث إذا كانت الفرضية (H) صحيحة. اختبار الجمل الشرطية تكون عن طريقة الصيغة التالية، إذا تم إحداث الشرط (C) وهو تسخين قطعة من النحاس، إذن سيحدث (E) وهو تمدد تلك القطعة. تلك الطريقة تمثل أساس البحث التجريبي. حيث يتم في المعمل إحداث الشرط (C) لنرى هل سيحدث (E) أم لا.
لكن كيف يتم تقييم واختبار الفرضيات من خلال نتائج التجارب؟ تحت عنوان كبير اسمه “المنهج العلمي” تقدم الكتب الدراسية ابتداءً من المدرسة حتى الجامعة طريقة أو طريقتين للمنهج العلمي، إما عن طريق الاستقراء أو عن طريق القابلية للتكذيب. الطريقة الاستقرائية عادة ما تُعزى إلى فرانسيس بيكون، والتي تنص على أنه حدوث النتيجة (E) تحت الشرط الذي فعلناه (C) هو ما يعتبر دليلًا مؤكِدًا على صحة الفرضية (H). وإذا ما تم الحصول على كثير من تلك الأدلة التأكيدية بشكل صحيح، لا بد على المجتمع العلمي أن يقبل بأن الفرضية (H) صحيحة. لكن للأسف، تلك الطريقة الاستقرائية تظهر مشكلتها الكبرى عند النظر الدقيق فيها، فإذا كانت الفرضيات في الأساس هي تعميمية كما قلنا إن “النحاس يتمدد بالحرارة”، والحديث هنا عن نوع النحاس بشكل عام، فلا يوجد أي عدد من التجارب المحدودة يكفي لإثبات ذلك التعميم الكبير. ونظرًا لتلك المشكلة التي تقف عائقًا لتعميمات الباحثين، فكان الحل أن بعض العلماء قدموا فكرة جديدة وهي القابلية للتخطئة، والتي تنص على أنه بالرغم من أن الفرضيات لا يمكن إثباتها أبدًا، إلا أنه من الممكن دحضها وإبطالها. وعلى عكس الاستقراء، فقد لاقت القابلية للتخطيء ترحيبًا كبيرًا لدى المناطقة. حيث يعتمد هذا المبدأ على قاعدة منطقية شهيرة تسمى «طريقة الاستثناء المنفصل modus tollens» وهي تنص على أن التعميم خاطئ إذا كان هناك على الأقل مثال واحد يخالفه. وبناءً عليه فإن فرضية “كل النحاس يتمدد بالحرارة” تعتبر خاطئة إذا كانت هناك حالة واحدة فقط من النحاس أو قطعة واحدة من النحاس لم تتمدد بالحرارة. وعليه، فعلى الرغم من أننا لن نتمكن أبدًا من إثبات صدق تلك الفرضية (لأنه لا يمكن أبدًا لأي عدد من التجارب أن تنحي احتمال أن قطعة نحاس ما، لن تتمدد بالحرارة في يوم من الأيام) أقول: على الرغم من أن تلك الفرضية لا يمكن أبدًا إثبات صدقها، إلا أنه من الواضح أنه يمكن إثبات خطئها. وتُعزى تلك الطريقة في الدوائر الفلسفية إلى العمل الذي قام به الفيلسوف النمساوي «كارل بوبر Karl Popper» الذي قام بمجهود فريد وطوّر تلك القاعدة المنطقية إلى شكل أكبر وأفضل لتكون جزءًا من الممارسات العلمية. الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ التخطيء هي وضع الفرضية تحت ظروف قاسية جدًا وصعبة جدًا، لدرجة أن الناظر إلى تلك الظروف القاسية لن يكون متأكدًا من النتائج المتوقعة. فإذا فشل التنبؤ، فسيتم استدعاء مبدأ الإستثناء «modus tollens» وبالتالي سيتم طرح الفرضية أرضًا ورفضها تمامًا. وبناءً على هذا المبدأ فإنه من غير العلمي أن يحاول المرء إثبات فرضية ما.
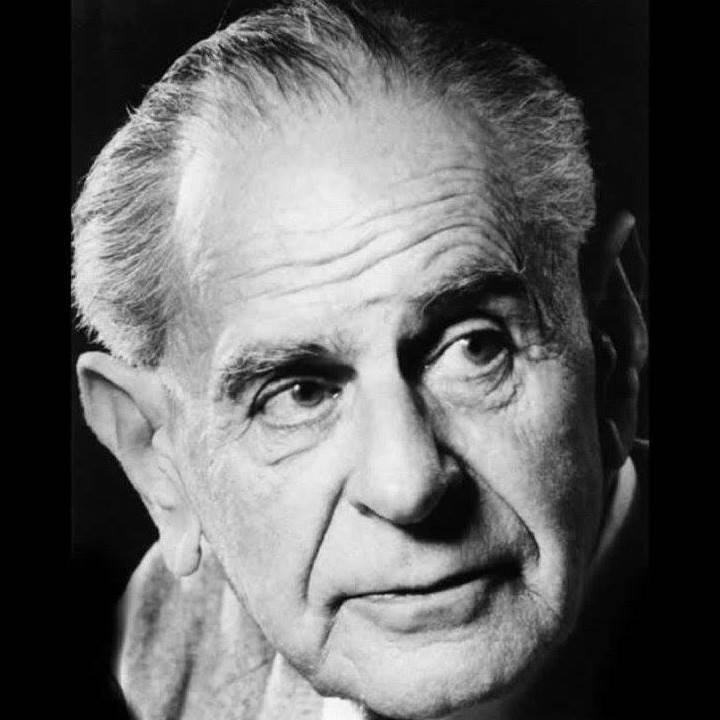
من أكثر من خمسين سنة، أدرك الفلاسفة أن مبدأ التخطيء به عوار كبير. ويمكن تلخيص هذا العوار في مشكلتين مركزيتين. الأولى: أي تجربة فعلية تقوم ظروفها على عدد كبير جدًا من المُسلّمات المُسبقة، سواء فيما يخص المُعدات والأجهزة المستخدمة أو الظروف المحيطة، ناهيك عن التسليم بصحة بعض النظريات العلمية التي يقبلها المجتمع العلمي. وعند أخذ كل هذه المسلمات في الاعتبار فإن مبدأ الإستثناء «modus tollens» قد يتغير تمامًا؛ ذلك أن خطأ النتيجة قد لا يكون مُعتمِد بالضرورة على خطأ الفرضية محل البحث، بل لربما كان الخطأ بسبب تلك المُسلمات التي تم الإقرار بصحتها. وذلك أمر معروف لأي طالب جامعي، لأنه وهو يقوم بإعادة التجارب التي يدرسها في المعمل، ربما يصل إلى نتائج خاطئة في كثير من الأحيان، لكنه يدرك أن ذلك الخطأ في النتيجة ليس سببه خطأ الفرضية التي يختبرها، بل بسبب خطأ الأدوات والمعدات المستخدمة في التجربة، أو بسبب فساد العينة التي يعمل عليها ويختبرها. أضف إلى ذلك أن تلك المشكلة لا يمكن التحايل عليها بتغيير تلك الظروف المحيطة بالتجربة، ذلك أن الظروف التي تحيط أي تجربة واقعية ليست معروفة كلها، وربما تصل إلى عدد لا نهائي، وهو من المستحيل التحكم فيها جميعًا والسيطرة عليها جميعًا. لأجل ذلك فإن مبدأ التخطيء الذي أتى به كارل بوبر قائلًا بأن الفرضية يتم رفضها لأجل مثال واحد خاطئ، يبدو أن هذا الكلام ما عاد يحمل مثقال ذرة من منطق سليم. علاوةً على ذلك، وكما قال الفيلسوف الأمريكي «توماس كون Thomas Kuhn» أن العلماء في واقعهم العلمي لا يمارسون مبدأ التخطيء أبدًا، بل ما يتم هو العكس من ذلك، فحين يفشل تنبؤ ما، يستمر العلماء في البحث والتجربة مُرجِعين السبب إلى الظروف المحيطة بالتجربة وليس الفرضية نفسها، بل إنهم يحاولون جاهدين إنقاذ وإسعاف فرضياتهم كي تعمل بأي صورة ممكنة، حتى لو أداهم إلى التشكيك في المُسلمات والفروض المحيطة بالتجربة. ومن الأمثلة الجيدة التي يمكن تقديمها على ذلك السلوك هو ما فعله علماء الكونيات في القرن التاسع عشر حين وجدوا اضطرابًا في مدار كوكب أورانوس، لم يمارس العلماء مبدأ التخطيء ورفضوا نظرية نيوتن في حركة الأجرام السماوية التي فشلت في تفسير مدار كوكب أورانوس، بل إنهم قبلوا نظرية نيوتن – بالرغم من مخالفة رصدهم مسار كوكب أورانوس لها – ورفضوا المسلمة القائلة بأنه لا توجد كواكب بعد كوكب أورانوس، وتم اكتشاف كوكب نبتون بعد ذلك. المهم هو أن المغزى من هذه القصة إن رفض الفرضية نتيجة تنبؤات خاطئة هو قرار في بعض الأحيان قد يكون غير صائب، فحتى لو فشل التنبؤ فلا يعني بالضرورة فشل الفرضية؛ ذلك أن المنطق يعطينا خيارًا آخر وهو أن العوامل والمسلمات والظروف المحيطة ربما هي الخاطئة وهي المعيبة وليس الفرض نفسه. باختصار، لا يفرض المنطق العلمي على العلماء أن يكونوا بالأساس باحثين عن التخطئة، ولا حتى العلماء أنفسهم يتصرفون بتلك الطريقة في بحثهم عن الأخطاء. وبناءً عليه، لا يمكن اعتبار مبدأ التخطئة هو المبرر لاعتبار نوع من العلوم أفضل من نوع آخر فيما يخص فحص وتجريب والتأكد من صحة الفرضيات.
دعنا نلقي نظرة عن قرب لنرى ماذا يفعل العلماء التجريبيون في الواقع وهم يفحصون فرضياتهم. إذا ما أردنا فحص الشرط (C) الذي تحدده الفرضية التي نريد إثباتها. إنهم يبقون هذا الشرط ثابتًا ويكررون التجربة مرارًا وتكرارًا إذا ظهرت نتائج لا تؤيد تلك الفرضية، لكنهم يعيدون التجربة مع تغيير باقي الظروف والشروط الأخرى. وهذه الطريقة وممارسة العلم بهذا الشكل هي نفس الطريقة التي تحدث عنها كارل بوبر ورفضها رفضًا قاطعًا، ذلك أن العلماء يحاولون إثبات صحة فرضياتهم بدلًا من محاولة إثبات خطئها، ويشككون في المسلمات والشروط المحيطة بدلًا من التشكيك في الفرضية نفسها. وإن كان كارل بوبر يرى أن تلك ليست هي الطريقة السليمة لممارسة العلم، وإن العلم هدفه دحض الفرضيات لا التحايل والإصرار على إثبات صحتها، إلا أن هذا السلوك يمكن أن ينظر إليه بشكل آخر غير ما نظر إليه بوبر، لم لا يُقال إنهم يحاولون حماية فرضياتهم من الفحص والتأكد غير السليم، وأنهم يتأكدون تمامًا أن العيب والخطأ ليس في أي شيء آخر حتى إذا تأكدوا من صحة كل الشروط والظروف، حينها يصح الحكم السليم على الفرضية نفسها. ذلك أن نفس الطريقة يتم استخدامها في حال الفرضيات السليمة، بل يمكن إزالة الشرط محل البحث للتأكد من أن وجوده وعدمه لا يؤثر في نتيجة التجربة. وعلى الرغم من أن هذه التصرفات تبدو كمحاولات لإثبات خطأ الفرضية، إلا أنها في حقيقة الأمر عبارة عن محاولات ساذجة وتحايل على الطريقة العلمية، ذلك أن بوبر يطلب من العلماء أن يُعرّضوا فرضياتهم إلى أقسى أنواع البحث والفحص والاختبار، وتلك محاولات بسيطة وهشة ولا ترقى للمستوى الذي يطلبه بوبر للتجارب وصرامتها. فهو يريد أن يصل إلى المرحلة التي يقال فيها بكل ثقة، لقد أخضعنا فرضياتنا إلى أشد وأعنف المحاولات والاختبارات، ولا نتوقع أن تخطئ هذه المرة. لكن ماذا لو فشلت التجربة في التنبؤ بما تفترضه النظرية؟ أيتم رميها واعتبارها فاشلة كما يقول بوبر؟ الحق أن ذلك لا يحدث، فحتى لو فشلت التجارب في إثبات تنبؤات الفرضيات، إلا أن العلماء يحاولون جاهدين إحياءها وإعطاءها قبلة الحياة، أو على الأقل يريدون التأكد بشتى الطرق أن المشكلة ليست في فرضياتهم، بل في الظروف والمسلمات المحيطة، حتى حين يتم رفض فرضياتهم، يتم رفضها بعد التأكد تمامًا من أنها فشلت فشلًا ذريعًا.
في ضوء ما سبق، دعنا نستدعي الآن ما يدعيه البعض من اختلافات إشكالية بين العلم التجريبي والعلم التاريخي. الحقيقة أن العلماء التاريخيين يمارسون علومهم وفق مبدأ القابلية للتكذيب بنفس الدرجة التي يمارسها ويطبقها العلماء التجريبون تمامًا. فكما ذكر ثلاثة علماء بارزون في علم الجيولوجيا في كتابهم الجامعي، حين كانوا يتحدثون عن ظاهرة انقراض الديناصورات، فقد كتبوا يقولون “إن العقيدة المركزية للمنهجية العلمية هي أن الفرضيات العلمية لا يمكن إثباتها، لكن يمكن تخطئتها”. ولنأخذ نظرية الانفجار الكبير فهي مثال جيد جدًا يمكن توضيح به ما نريد، حيث إنها تفترض حدوث أو صدور أشياء يمكن أن نختبرها ونرصدها الآن في وقتنا المعاصر. على سبيل المثال إشعاع الخلفية الكونية الذي تم اكتشافه عن طريق أقمار وأجهزة للاتصالات في ستينيات القرن الماضي. وهذا الرصد لتلك الظاهرة التي افترضتها النظرية التاريخية، يساوي تمامًا أي نتيجة تخبرنا عنها التجربة المعملية لأي فرضية تجريبية نثبت بها صحتها. على الرغم من وجود احتمال ضئيل جدًا أو ربما لا يوجد أي احتمال أصلًا ولا أي إمكانية لاختبار تلك الفرضيات التاريخية داخل المعمل، ذلك أن الوقت المطلوب كبير للغاية، فقد حدث الانفجار العظيم منذ ١٤ مليار سنة، والظروف التي نحتاجها في المعمل تكاد تكون مستحيلة كي نعيد تجربة الانفجار الكبيرة مرة ثانية.
على الرغم من الصعوبة التي تقترب من الاستحالة في اختبار الأحداث الماضية، إلا أنه لا يعني بحال من الأحوال أن الفرضيات التاريخية لا يمكن اختبارها، فعالم الجيولوجيا «تشامبرلين T.C. Chamberlin» قد ذكر أن الباحث التاريخي عليه أن يجد أكثر من فرضية محتملة لتفسير الحدث الذي أدى للظواهر التي نراها الآن بدلًا من اقتراح فرضية واحدة فقط. وتعريض جميع الفرضيات تلك إلى أقسى الظروف من المراجعة والفحص، أملًا في أن تنجو فرضية منهم وتنجح في تفسير الظواهر الحالية رغم ما تعرضت له من فحص واختبار. وهو ما يجعل تلك الطريقة التي أتى بها تشامبرلين تحمل في طياتها روح القابلية للتكذيب. نرجع فنقول، هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية فإن الباحثين يحاولون تأكيد نظرياتهم وفرضياتهم لا تكذيبها ودحضها، فهم يحاولون الوصول إلى أدلة دامغة لتثبت صحة فرضياتهم أو فرضية بعينها لتتفوق على باقي الفرضيات وتكون هي التفسير الأفضل.
ولنأخذ فرضية النيزك التي اصطدم بالأرض وتسبب في انقراض الديناصورات فهي تعد مثالًا جيدًا على ما نقول. قبل عام 1980 كان هناك العديد من الفرضيات التي تحاول تفسير حدث انقراض الديناصورات، من بينها تفسير هذا الانقراض بسبب وباء قاتل، وأخرى تفترض أنه بسبب التغير المناخي، وفرضية ثالثة تقترح أن السبب هو بركان أدى إلى إبادتهم. والفرضية الأخيرة هي فرضية النيزك التي تسبب فيما حدث. لكن بعدما تم اكتشاف كميات كبيرة من الإيراديوم في القشرة الأرضية يعود تاريخها إلى نهاية العصر الطباشيري، تم إهمال باقي الفرضيات والتركيز على فرضية النيزك إذ أن عنصر الإيراديوم ليس موجودًا بكثرة في الأرض، وإنما يوجد بكثرة في بعض النيازك والكويكبات. وكان لاكتشاف معدن المرو quartz أثر كبير في الإعراض عن نظرية البركان، إذ تلك الكمية الكبيرة من معدن المرو لا يمكن أن يكون سببها بركان. لكن على الرغم من اكتشاف وجود تلك العناصر في القشرة الأرضية التي ترجع إلى ذلك العصر، فلم يكن ذلك دليلًا دامغًا على فرضية النيزك، إذ كان يلزم بعض الأدلة الأخرى أو البحث عن هذا الدليل الدامغ، وكان الدليل الدامغ لإثبات فرضية النيزك وربطها بانقراض الديناصورات قد وُجد عندما وجد العلماء أن الديناصورات انقرضت بشكل سريع جدًا في نفس الوقت الذي وجد فيه عنصر الإيراديوم والمرو بكميات كبيرة في ذلك العصر، وهو ما يعني أن العلاقة قوية، بل وقوية جدًا على ربط هذين الحدثين ببعضهما. ففي ضوء محدودية الفرضيات المقدمة، وفي ضوء الأدلة المقدمة (السجلات الأحفورية، عنصر الإيراديوم، عنصر المرو، الفوهات الغائرة في الأرض) لم يعد أمامنا إلا التسليم بأن فرضية النيزك هي السبب المنطقي والعقلاني لفهم حادثة انقراض الديناصورات.

وعلى الرغم من أن العلم التاريخي ينطوي على عمل تجارب داخل المعمل، إلا أن هدفه وغايته تختلف عن هدف وغاية العلوم التجريبية؛ فالبحث التاريخي يهتم بأداء التجارب وفحص العينات داخل المعمل لكي يفهمها بشكل جيد، وكي يستطيع الإتيان بفرضيات أدق عن الأسباب التي حدثت في الماضي، فهو لا يهمه العينات والتجارب في ذاتها، بل يهمه فحصها لمعرفة ماذا حدث في الماضي من أحداث أدت إلى ما نراه في وقتنا الحاضر. ومن الأمثلة على ذلك هو الفرض القائل بأن الحياة بدأت على كوكب الأرض منذ ما يقرب من حوالي 3.8 مليار سنة يرجع في الحقيقة إلى فحص معملي لنظائر الكربون لقطعة صغيرة جدًا جدًا من الصخور تصل إلى 0,01 مليمتر. لا يعتمد العلم التاريخي فقط على التجارب والاختبارات المعملية لعينات حاضرة، لكنه يعتمد في بعض الأحيان على فحص واختبار، بل ومراجعة المسلمات التي تقوم عليها التجربة نفسها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك تجربة ميلر-يوري التي تم الترويج لها على أنها تدعم الفرضية القائلة بأن الحياة على الأرض بدأت في حساء بدائي، ولكنها تقوم في الواقع على المسلمة القائلة بأن بعض العناصر الأساسية للحياة (الأحماض الأمينية) يمكن إنتاجها عن طريق التفريغ الكهربائي لخليط من الميثان، والهيدروجين، والأمونيا، والماء. وفي هذا السياق، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن معظم العلماء يعتقدون الآن أن أصل الحياة على الأرض لا يتوافق مع ظروف تجربة ميلر-يوري. يُعتقد أن الغلاف الجوي المبكر للأرض لم يكن يحتوي على وفرة من الميثان أو الأمونيا، وأن الحياة ربما بدأت بالقرب من فتحة بركانية في أعماق البحار. أي أن العلماء الآن يرفضون الأسس نفسها والظروف والمسلمات نفسها التي قامت عليها تلك التجربة.
وبالمثل، من المهم عدم الخلط بين النمذجة أو المحاكاة بمساعدة الكمبيوتر التي أصبحت شائعة في الأبحاث التاريخية وبين إجراء تجارب معملية منضبطة؛ ذلك أن أقصى ما يمكن أن يفعله الكمبيوتر هو تحديد نتائج الفرضية محل البحث في ظل عدد صغير من الشروط التي افترضها ووضعها الباحث. ومن المهم كذلك التأكيد على أنه لا يمكن تحديد ومعرفة أي من هذه الشروط الافتراضية موجود بالفعل في النظام الفيزيائي الملموس الذي يتم نمذجته. ثم حتى لو افترضنا وجود نفس الشروط والعوامل في النظام الفيزيائي ووضعها داخل الكمبيوتر لنمذجتها، فلا يمكن للباحث أن يلم بجميع الشروط والعوامل الفيزيائية كلها ووضعها داخل نظام المحاكاة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك والتي سيكون لذكرها فائدة هي عمليات المحاكاة المناخية لفرضية “أرض كرة الثلج” التي تقترح أن الأرض ستتجمد وستكون في النهاية كرة ثلج كبيرة، والتي أشارت تلك الفرضية إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يوقف في وجه هذا التجمد الثلجي العالمي. لقد فشل واضعو تلك النماذج للمحاكاة المناخية في أخذ نشاط البراكين بعين الاعتبار، حيث ستستمر البراكين في إطلاق ثاني أكسيد الكربون أثناء التجمد العالمي، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج ظاهرة الاحتباس الحراري التي من شأنها أن تذيب الجليد بسرعة وبالتالي يمكنها إيقاف تحول الأرض لكرة ثلج. النقطة المهمة هي أن نمذجة الأحداث الماضية هي في النهاية عمل نظري، ورغم أنها قد تسفر عن تنبؤات، إلا أن هذه التنبؤات تكون دقيقة وصحيحة بقدر الافتراضات التي يضعها الباحث داخل النموذج ليستند إليها الكمبيوتر في محاكاته. وأفضل ما يمكن فعله من خلال تلك المحاكاة هو أن نبحث عن الظواهر والتنبؤات التي يخبرنا بها النموذج لنرى إذا ما كانت موجودة في الطبيعة أم لا. وحتى لو بحثنا عن التنبؤات الحوسبية ولم نجدها في الطبيعة فلا يعني بالضرورة أن الفرضية فاشلة، فحتى مع صحة الفرضية، ليس مضمونًا أن تصدق المحاكاة في وصفها للعالم الفيزيائي. وهو ما يقودنا إلى النقطة الحاسمة: على الرغم من أن النماذج المدعومة بالكمبيوتر قد تقترح ما يجب البحث عنه في الطبيعة، ويمكن التحقق من الآثار وبعض الافتراضات المساعدة في المختبر، إلا أنه لا يمكن إجراء اختبار تجريبي في المعمل لفرضية تاريخية. ناهيك عن استحالة إعادة الزمن وتكرار ما حدث في الماضي داخل المختبر، هذا أمر من المستحيل فعله واختباره.
باختصار، كان «هنري جي Henry Gee» المحرر في مجلة نيتشر على حق فيما يتعلق بوجود اختلافات جوهرية في المنهجية المستخدمة من قبل العلماء التاريخيين والعلماء التجريبيين. فمن جهة يركز العلماء التجريبيون على فرضية واحدة (غالبًا ما تكون معقدة)، ويتمثل نشاطهم وعملهم البحثي بشكل رئيسي على تكرار شروط وظروف التجربة التي تحددها الفرضية محل البحث والنظر، ويحاولون التحكم في العوامل أو الظروف الخارجية التي قد تتسبب في تغيير نتائج التجربة. وعلى النقيض من ذلك، يركز علماء التاريخ عادةً على صياغة فرضيات متعددة متنافسة حول أحداث ماضية معينة. وتتمثل جهودهم البحثية الرئيسية في البحث عن الدليل الدامغ، وهو الأثر الذي يميز ويرجح إحدى الفرضيات بأنها أكثر صلاحية باعتبارها أنها دون غيرها من الفرضيات هي ما تقدم ترابطًا قويًا بين الأدلة التي نرصدها وبين الأحداث التي قد تكون حدث في الماضي وأدت إلى ما نراه الآن. ومع ذلك، ورغم هذه الاختلافات في كيفية عمل المنهجين إلا إن هذه الاختلافات في المنهجية لا تدعم أبدًا الادعاء القائل بأن العلم التاريخي أقل شأنًا من الناحية المنهجية، لأنها تعكس اختلافًا موضوعيًا في علاقة الأدلة التي نراها الآن وبين الجانب التاريخي والجانب التجريبي، فالأدلة نفسها التي بين أيدينا هي التي تحتم على كل باحث أن يكون منهجه وتعامله معها مختلفًا وتقييمه لها مختلفًا، فلا فضل لأحدهما على الآخر.
عدم التناظر الحتمي بين الماضي والمستقبل:
تميل الأحداث إلى عدم التناظر في أسبابها ما بين المستقبل والماضي، ولفهم هذه الجملة المعقدة دعنا نوضح ما نقول بمثال. تخيل معي النتائج المترتبة على ثوران أي بركان، سيكون هناك رواسب، سيكون هناك غازات سامة، سيكون هناك معادن من باطن الأرض موجودة على السطح، وغيرها الكثير من تلك الآثار. فلننظر إلى ثوران البركان كأنه حدث قد تم في الماضي، فكي نستطيع معرفة ما إن ثار بركان ما في الماضي، لا نحتاج إلى كل تلك الآثار، إن واحدة منها تكفي لمعرفة إذا ما كان هنا بركان أم لا. فلا يلزم أن يرى الإنسان الغازات السامة، والمعادن الأرضية، ودرجة الحرارة العالية ليحكم أن بركانًا قد حدث، تكفي واحدة فقط، بل يكفي حطام صغير جدًا من تلك المادة التي خلفها البركان لنعرف يقينًا أن هاهنا بركانًا قد حدث. لكن فلنفترض نفس المثال لكن بدلًا عن الماضي، دعنا نفترض أنه في المستقبل، ماذا نحتاج لنعرف أن بركانًا ما سوف يحدث في المستقبل؟ هل يكفينا دليل واحد أو عامل واحد أو أثر واحد لنحكم به أن هذا البركان سوف يثور؟ يبدو أن الحكم على أن بركانًا سوف يثور في المستقبل لا يعتمد على عامل واحد، بل على عوامل كثيرة جدًا كي تستطيع الحكم والتنبؤ بأن بركانًا ما سوف يثور، ومن الصعب جدًا الإحاطة بجميع العوامل التي تؤثر في ثوران بركان ما.
يطلق الفيلسوف الأمريكي «ديفيد لويس David Lewis» على تلك الحالة «عدم تناظر الحتمية المفرطة the asymmetry of overdetermination»، وهو ما يعني أن الأحداث الماضية يمكن معرفة أسبابها بسهولة، لكن الأحداث المستقبلية تتسم بصعوبة بالغة في تحديد أسبابها. ولنشرح ذلك بمثال آخر: إن أردت أن تقوم بجريمة مكتملة الأركان بحيث لا يعرف أحدٌ أنك قد ارتكبت هذه الجريمة، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب عليك أن تزيل أثار أقدامك، وبصمات أصابعك، وأي جزء من أجزاء جسدك، بل وحتى أثار الجريمة، ولو وصلت إلى الأشعة التي يتركها جسدك في الفضاء الذي تكون موجودًا فيه. كي تقوم بجريمة ولا يعرف بها أحد، لا يكفيك أن تزيل واحدةً فقط مما سبق، بل يجب أن تمحيَ جميع هذه الأثار برمتها، إذ لو فشلت في إزالة أثر واحد من هؤلاء، فإن «شارلك هولمز Sherlock Holmes» سوف يحقق في الأمر وسيعرف أنك قد ارتكبت تلك الجريمة وسيتم القبض عليك ومحاكمتك. إذن فللقيام في المستقبل بجريمة ما، لا بد أن تفعل أشياء عديدة جدًا والتأكد من عدم وجود أي أثر، لكن ليس الأمر كذلك من ناحية الماضي، فكي نعرف أن جريمة قد ارتكبها شخص ما، يكفينا أثر واحد فقط وهو أثار الرصاص أو بصمات اليد لنعرف أنه قد فعلها في الماضي، وهذا تحديدًا ما نقصده بعدم التناظر السببي، فالأحداث في المستقبل يصعب تحديدها، في حين أن الأحداث في الماضي يسهل معرفة أنها حدثت من خلال أثر واحد على الأقل.
لا يزال سبب عدم التناظر هذا مثيرًا للجدل وغير محسوم، فالبعض يحاول تفسير عدم التناظر بين الماضي والمستقبل بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية، والبعض الآخر يحاول عزوه إلى عدم التماثل الإشعاعي والتدرج من الشروط الأولية التي بدأت مع الكون حتى يوم الناس هذا. ولكن، أيًا ما كان سبب عدم التناظر بين الماضي والمستقبل، إلا أن العلماء متفقين على وجود هذه الظاهرة في الطبيعة، على الأقل في العالم الموضوعي الذي نراه فيما يخص ظواهر مثل البراكين، والصخور، والحفريات، والبصمات، والنجوم.
يمكن لمبدأ عدم التناظر في الحتمية بين الماضي والمستقبل أن يكون ردًا على أولئك الذين يأتون بالاختلافات الإشكالية المزعومة بين العلوم التاريخية والتجريبية فيما يخص القدرة على اختبار الفرضيات في كل علم منهما. وكما أن هناك العديد من الاحتمالات والطرق المختلفة للقبض على المجرمين، فإن هناك العديد من الاحتمالات والطرق المختلفة لتحديد سبب انقراض الديناصورات. مثل ما يقوم به المحققون الجنائيون، يقوم علماء التاريخ بجمع الأدلة، والنظر في المشتبه بهم، واتباع ما يقود إليه ما بين أيدينا من ظواهر. بل إنهم يقومون بعلمهم بشكل أكثر دقة، فإنهم يفترضون أسبابًا عديدة وفرضيات كثيرة ومختلفة للآثار التي يلاحظونها، ثم يحاولون التمييز بينها واختيار الفرض الأفضل من خلال البحث عن دليل دامغ – وهو الأثر الذي سيحدد الجاني دون أي شك.
يكمل الفيلسوف الأمريكي «ديفيد لويس David Lewis» كلامه عن هذا المبدأ ويقول أنه وبالرغم من أن هذا المبدأ يقوم بالأساس على وجود سبب كاف يضمن لك وقوع حدث ما في الماضي، إلا أن الأمر ليس بهذه الدقة واليقين في كل مرة وعن أي حدث، فمن الممكن أن توصلنا الأدلة إلى احتمال ظني بوقوع حدث ما في الماضي، وليس بالضرورة معرفة يقينية، ما يعني أنه يكفينا الاتيان باحتمالية كبيرة لوقوع حدث ما. وسواء كان معرفتنا يقينية أو احتمالية بوقوع حدث ما في الماضي، فإن الأمر طبيعي في كلا الحالتين بالنسبة لأفعال البشر وتجاربهم وحياتهم. ولا يظنن أحد أن العلوم التجريبية تعطينا يقينًا في كل أمر فيها، فالطريقة التجريبية فيها شك واحتمالية هي الأخرى والتي لا يمكن أبدًا التخلص منها والوصول إلى اليقين المطلق. لكن الأمر المميز في المنهجية التاريخية أنك بالنظر إلى دليل واحد بسيط، فهو يعطيك احتمالًا كبيرًا على وقوع حدث ما في الماضي، وهذا وحده كافٍ جدًا في علومنا ومعارفنا، بل من السهل الوصول إلى التأكد من وقوع حدث ما إذا ما وصلنا إلى دليل دامغ على حدوثه كما يفعل المحققون في بحثهم بشكل قاطع عن الجاني.
يمكن الوصول إلى هذا الدليل القاطع بشكل مباشر من خلال الفرضية نفسها، فعلى سبيل المثال، يقول عالم الفيزياء الأمريكي «روبرت ديكي Robert Dicke» أنه إذا كانت فرضية الانفجار العظيم صحيحة وحدثت بالفعل، فإن النتائج المترتبة عليها أن يكون الكون به إشعاع متناسق في جميع جهاته، تكون درجه حرارته أعلى من الصفر المطلق، أو ما يطلق عليه إشعاع الخلفية الكونية. كان اكتشاف «ويلسون وبنزياس Wilson and Penzias» لتلك الإشعاعات الغريبة التي تبلغ درجة حرارتها ثلاث درجات على مقياس كلفن، قد تم اعتباره بعد ذلك دليلًا دامغًا على صدق وصحة ما تم فرضه سابقًا من حدوث الانفجار العظيم وترجيح تلك الفرضية على غيرها من الفرضيات الأخرى.

لكن الأمر ليس كذلك في كل الفرضيات، فبعض الفرضيات تأتي هي بما تعتبره دليلًا دامغًا على صحتها، وبعض الفرضيات الأخرى لا تسمح بذلك، وليس أمام الباحث إلا أن يكون محظوظًا ليقع تحت يديه دليلٌ دامغ على صحة فرضية دون الأخرى، ففي حالة انقراض الديناصورات، لم تقدم الفرضية التي اقترحت حدوث الانقراض بسبب نيزك، لم تقدم الفرضية ما يمكن أن يكون دليلًا دامغًا على صحتها، ولولا أننا اكتشفنا وجود عناصر مثل الإيراديوم والمرو، لما تمكنا من التأكد من صحة الفرضية. أضف إلى ذلك أن تلك الأدلة ربما تقل مع مرور الزمن، وربما تتدهور، بل لربما تعدم تمامًا، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى تقدم تكنولوجي وأجهزة غاية في التطور كي نتمكن من معرفة تلك الأدلة الدامغة، ففي حالة اكتشاف أشعة الخلفية الكونية كانت الآلة المستخدمة هي جهاز ذو قدرة عالية جدًا على الاستشعار ويعمل بالأقمار الصناعية. الأمر نفسه يمكن أن يقال في حالة اكتشاف عنصري الإيراديوم والمرو فلولا اختراع مسارع جسميات عالي التطور ما كنا لنصل إلى معرفة ما حدث في نهاية العصر الطباشيري. وهكذا دائمًا تختلف نوع الأدلة وجودتها وكيفية الحصول عليها باختلاف الزمن والتقدم التكنولوجي، وبالتالي يظل الأمر في حيز الاحتمالات والمحاولات في الأبحاث التاريخية كما هي الحال نفسها تمامًا من الاحتمالات والمحاولات في الأبحاث التجريبية. الأمر الذي يجب التنبيه عليه في النهاية أن الإنسان لا يقف أبدًا عن محاولة بحثه عن دليل دامغ، إذ أن الفشل في وجود هذا الدليل يجعل الفرضية التاريخية مجرد فرضية لا دليل عليها.
نعود إلى الحديث عن العلوم التجريبية ونقول إن معرفة أسباب حدث ما هي مسألة غاية في التعقيد والتركيب، تخيل معي حدوث ماس كهربائي تسبب في إحراق المنزل، كي نعرف أسباب حرق المنزل لا بد أن تتوافر أشياء كثيرة جدًا، لا بد من حدوث الماس الكهربائي ووجود المواد القابلة للاشتعال وغياب أدوات إطفاء الحريق وهلم جرًا. ناهيك عن أن غياب سبب واحد من هؤلاء كاف لعدم حدوث الحريق في المستقبل. لكن لا يحتاج المرء إلى الاطلاع على جميع تلك الأسباب لمعرفة إذا ما تم الحريق أم لا، يكفيه دخان الحريق فقط ليعرف أن المنزل قد حرق.
هذا الأمر يوضح بشكل كبير صعوبة إجراء الأبحاث التجريبية إذ يحتاج الباحث الإلمام بجميع الأسباب كي يقول أن حدثًا ما سوف يحدث في المستقبل، أو أن فرضيته تتنبأ بحدوث أمر ما. لذلك يحاول الباحثون التجريبيون إعادة وفحص وتغيير تجاربهم مرارًا وتكرارًا لضمان معرفتهم للأسباب، ولضمان اختبار فرضياتهم، لذلك فإن العلماء التجريبيين يحاولون إثبات فرضياتهم وإحيائها، بل يحاولون حمايتها من التخطيء على عكس ما كان يقول كارل بوبر.
خاتمة:
عندما يتعلق الأمر باختبار الفرضيات، فإن العلوم التاريخية ليست أدنى شأنًا من العلوم التجريبية التقليدية. كما لا يمكن استخدام التفسيرات التقليدية للمنهج العلمي لدعم ادعاء البعض بتفوق البحوث التجريبية. علاوةً على ذلك، فإن الاختلافات في المنهجية الموجودة بالفعل بين العلوم التاريخية والتجريبية مردها إلى سمة موضوعية ومنتشرة في الطبيعة، وهي عدم التناظر في الحتمية بين الماضي والمستقبل. وبقدر ما تستغل كلُ ممارسةٍ بشكل خاص بها المعلومات المختلفة التي تضعها الطبيعة أمام الباحث، فلا توجد أسباب تدعم الادعاء القائل أن فرضيات المنهج التجريبي يتم إثباتها بشكل أكثر موثوقية من الفرضيات الخاصة بالمنهج التاريخي.