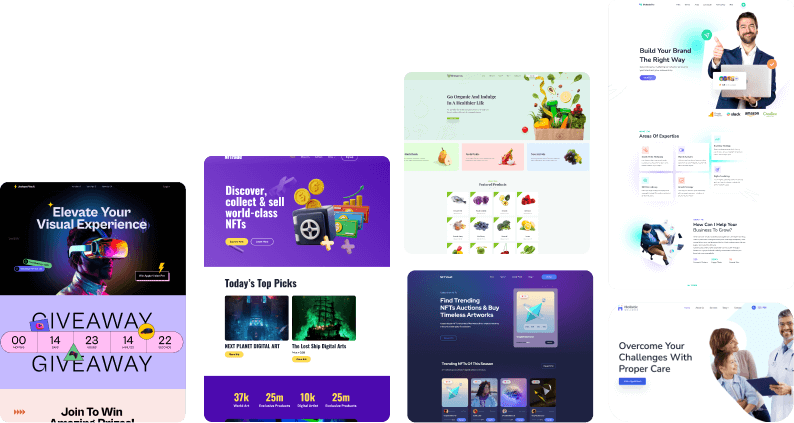المرض إكس
اعتادت منظّمة الصّحة العالميّة إصدار تقريرٍ سنويٍّ عن قائمة الأمراض والأوبئة الّتي تعصف بالعالم من حيث الأهمّيّة والخطورة، والّتي يجب على دول العالم التّصدّي الفوريّ لها. إلّا أنّه في شهر فبراير عام 2018 وفي تقرير منظّمة الصّحّة العالميّة عن الأمراض الّتي يجب أن تُوضع على قِمّة هرم الأولويّة، أضافوا في نهاية القائمة -ولأوّل مرّةٍ- مرضًا أطلقوا عليه اسم «المرض إكس – Disease X» أو المرض المجهول.[1] وما عنته منظّمة الصّحّة العالميّة أنّ هذا اسمٌ لمرضٍ مجهولٍ لنا الآن، ومجهولةٍ أسبابه. ولكنّهم أضافوا تلك الخانة الفارغة «المرض إكس» كنايةً عن توقّع نشوء مرضٍ لا نعرفه الآن قد يتسبّب في وباءٍ أو جائحةٍ عالميّةٍ. حيث تعمل المنظّمة على التّأهّب من الآن للمحاربة الفوريّة وأن تكون على أهبة الاستعداد لمقاومة هذا المرض المستقبليّ المجهول.[2] لذلك يمكن أن يصدق فيهم المثل المصريّ القائل: «يقدّرون البلاء قبل وقوعه». ومن الواضح الآن أنّ إضافة منظّمة الصّحّة العالميّة لهذه الخانة الفارغة لأيّ مرضٍ قد يتفشّى في بني الإنسان، كان خيارًا سليمًا حيث نرى ونعيش الآن جائحة كورونا الّتي تفشّت بعدها بسنتين.
بداية القصة
لكنّ القصّة خلف لقاح أوكسفورد لا تبدأ عام 2020، ولا تبدأ بمرض كورونا، بل حتّى لا تبدأ من دولة الصّين في آسيا. إنّما بدأت قبل تفشّي هذا الوباء بسنواتٍ كثيرةٍ، أكثر من 25 سنةٍ، تبدأ القصّة من إفريقيا وبمرض الملاريا على وجه التّحديد. حين التحقت سارة جلبرت (Sarah Gilbert) بجامعة أوكسفورد، لتعمل في معهد جينر (Jenner Institute) عام 1994، وفي ذلك الوقت كان قد انتشر وباء الملاريا في دول غرب إفريقيا. فعملت على فحصه ودراسته، ثمّ عملت بعد ذلك على الكثير من الأمراض والحمّيات الفيروسيّة بهدف إنتاج لقاحاتٍ لها. كمرض الإيبولا، وحمّى الوادي المتصدّع (Rift Valley fever) و فيروس لاسا (Lassa virus) و فيروس نيباه (Nipah virus)، بل من أشهرها فيروس كورونا ميرس (MERS-CoV) الّذي انتشر في الشّرق الأوسط وفي السّعودية على وجه التّحديد.

كان هدف سارة جلبرت هو العمل على إنشاء نظامٍ كاملٍ لإنتاج لقاحاتٍ تعمل ضدّ أيّ فيروسٍ، حيث يُبنى النّظام المتكامل وتُترك فيه متغيّراتٌ بسيطةٌ لإضافة تركيب الفيروس الخاصّ بالمرض المعيّن. وحين يوضع تركيب الفيروس في هذا النّظام، سيتمكّن النّظام من تطوير لقاحٍ مضادٍّ لهذا الفيروس. وبالفعل تمكّنت من ذلك، وطُوّر لقاحٌ ضدّ فيروس ميرس وضدّ الإيبولا وضدّ الملاريا وضدّ فيروس زيكا (Zika) وغيرهم بتلك الطّريقة. ولا تزال التّجارب السّريريّة مستمرّةً حتّى اليوم.[3]
المسألة بشكلٍ بسيطٍ أشبه بهذه المعادلة:

تكمن الصّعوبة في كتابة المعادلة نفسها، ومعرفة هذه الأرقام. وسيكون حلّ المعادلة سهلًا جدًّا إذا علمت قيمة (x)، سأحصل بسهولةٍ على قيمة (y). بمعنًى أخر، هذا هو النّظام، ضع فيه التّركيب الجينيّ للفيروس الجديد (x)، وسينتج لك بشكلٍ سريعٍ اللّقاح المضادّ له (y).
وفي هذا الفيديو القصير شرحٌ مبسّطٌ لكيفيّة عمل اللّقاح:
كان الفريق البحثيّ في معهد جينر في جامعة أوكسفورد يتساءل خلال الفترة الماضية حول المرض إكس: هل يا تُرى، لو ظهر مرضٌ لا نعلمه الآن وانتشر في العالم، فهل سنكون مستعدّين لمواجهته بشكلٍ سريعٍ ومُتقنٍ؟ وبينما هم يفكّرون في إجابةٍ عن هذا السؤال، إذ ساقت لهم الأخبار نبأ انتشار فيروسٍ جديدٍ في مدينة ووهان في الصّين، فكأنّما قد أعطت لهم الأقدارُ فرصةً على طبقٍ من ذهبٍ ليتأكّدوا عمليًّا من إجاباتهم على السّؤال سالف الذّكر.
وحينها انتهزت سارة جلبرت الفرصة هي وفريقُها للعمل على هذا المرض الجديد. ليختبروا قدراتهم الّتي أعدّوها قبل ذلك، ما إن نشر العلماء الصّينيّون التّركيب الجينيّ للفيروس يوم 11 يناير. تقول الدّكتورة تريسا لامبي (Teresa Lambe) أنّ ما أيقظها ذلك اليوم هو صوت البريد الإلكترونيّ حاملًا إشعار نشر الورقة العلميّة الصّينيّة بالتّركيب الجينيّ للفيروس، لتبدأ فورًا بتصميم اللّقاح مع باقي أعضاء الفريق. وفي خلال يومين اثنين، السّبت والأحد، عمل الفريق ليل نهارٍ على اللّقاح الجديد، وانتهوا من تصميمه بشكلٍ شبه كاملٍ بنهاية يوم الأحد 12 يناير.[4]
بعد تصميم اللّقاح، أرسلت الدّكتورة سارة جلبرت إلى الدّكتورة كاثرين جرين (Catherine Green) رئيسة وحدة التّصنيع في جامعة أوكسفورد، تطلب منها المساعدة في صناعة هذا اللّقاح -الّذي صمّموه- في المصنع الصّغير الّذي ترأسه الدّكتورة كاثرين في جامعة أوكسفورد في أسرع وقتٍ ممكنٍ، حتّى يتمكّنوا من إنتاج كمّيّاتٍ كبيرةٍ من اللّقاح، ما يؤهّلهم إلى أخذ الخطوة التّالية وهي بداية التّجارب السّريريّة على الحيوانات ثمّ بعد ذلك على البشر.[5]
لم يكتف علماء أوكسفورد بتصميم وصناعة اللّقاح داخل جامعة أوكسفورد، بل كانوا هم أوّل من جرّبوه على أنفسهم. فقد كانت أوّل متطوّعةٍ يتمّ تطعيمها هي الباحثة إليسا جراناتو (Elisa Granato) في جامعة أوكسفورد. ومن المؤسف أنّه قد أُشيع خبر وفاتها بعد تلقّيها للّقاح، لكنّها خرجت وصرّحت بأنّها لم تمت كما يزعم النّاس وتتمتّع بكامل الصّحّة والسّلامة.[6]
خطأ في التجارب
كان من الصّعب أن تنتج أوكسفورد بمصنعها الصّغير كمّيّاتٍ كبيرةً جدًّا من اللّقاح، ومن ثمّ كان التّعاون مع شركة آسترازِنِكا (Astrazeneca) البريطانيّة لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح أوكسفورد في مصانع تلك الشّركة. كما اتّفقت الجامعة والشّركة على أنّهما لن يتربّحا ملّيمًا واحدًا من اللّقاح أثناء الجائحة، وحتّى بعد الجائحة ستستمرّ الشّركة في عدم التّربّح من إنتاج اللّقاح في الدّول الفقيرة والنّامية. كما صرّحت أوكسفورد أنّ أيّ أموالٍ ستحصل عليها بعد الجائحة، ستُستثمَر في الأبحاث العلميّة في المجالات الطّبّيّة والحيويّة.[7] وبدأت التّجارب السّريريّة تأخذ نطاقًا واسعًا، فأجريت في البرازيل -حيث كانت نسبة العدوى والوفيات كبيرةً جدًّا، الثّانية عالميًّا في ذلك التّوقيت- وفي بريطانيا كذلك.
كانت فعالية اللّقاح تصل إلى 62%، إلّا أنّ الباحثين قد لاحظوا في إحدى التّجارب أنّ المرضى أصيبوا بأعراضٍ جانبيّةٍ خفيفةٍ، وكان من المفترض أن تكون الأعراض الجانبيّة أكثر شدّةً ممّا حدث للمرضى. فراجعوا حساباتهم فوجدوا أنّهم -وعن طريق الخطأ- أعطوا المرضى نصف جرعةٍ من اللّقاح وليس جرعةً كاملةً. فقرّروا أن يستمرّوا في التّجارب وأن يعطوهم في المرّة الثّانية جرعةً كاملةً. وفي هذه الحال، زادت فعالية اللّقاح إلى 90%، بسبب ذلك الخطأ الّذي لم يكن مقصودًا. واعتُمد لقاح أوكسفورد بنصف جرعةٍ أوّلًا، تليها بعد ذلك جرعةٌ كاملةٌ.[8]
ربّما يذكّرنا هذا الموقف بإجابة الدّكتور أحمد زويل حين سُئل عن إيمانه بالحظّ، فقال:
«الحظّ لا يأتي إلّا لمن يستحقّونه.»[9]
لماذا لقاح أوكسفورد؟
وإذا كانت أوكسفورد قد أعدّت لتطوير اللّقاح قبل انتشار المرض بأكثر من عقدين، وإذا كانت قد بدأت العمل عليه في نفس اليوم الّذي نشر فيه العلماء الصّينيّون التّركيب الجينيّ للفيروس، وصمّموا اللّقاح في خلال 48 ساعةٍ فقط، وفي إجازة نهاية الأسبوع. بل بدأوا تصنيع اللّقاح أيضًا داخل مصانع الجامعة قبل التّعاون مع شركة آسترازِنِكا البريطانيّة، فمن المهمّ أن نعرف ما الّذي أوصل أوكسفورد لهذه الدّرجة الكبيرة من التّقدّم وقيادة العالم؟ لماذا أوكسفورد تحديدًا دونما باقي جامعات وشركات العالم؟ أو بصيغةٍ أخرى، ما الّذي يميّز أوكسفورد في تطويرها للّقاح في حين أنّ هناك الكثير من المؤسّسات قد طوّرت هي الأخرى لقاحاتٍ أيضًا؟ فهناك شركاتٌ أمريكيّةٌ وشركاتٌ ألمانيّةٌ وصينيّةٌ وروسيّةٌ لديهم لقاحاتٌ تمامًا كأوكسفورد، فما الّذي يجعل لقاح أوكسفورد ذا قيمةٍ عن غيره؟

أقول: إنّ الّذي يجعل قيمة لقاح أوكسفورد أكبر من غيره من اللّقاحات، أنّ كلّ اللّقاحات الأخرى لم تطوّرها جامعاتٌ، فاللّقاح الصّينيّ طوّرته شركة سينوفاك بَيوتك (Sinovac Biotech) الصّينيّة ومقرّها بكين.[10] واللّقاح الرّوسيّ طوّره معمل أبحاث جاماليا (Gamaleya Research Institute)، وهو معملٌ خاصٌّ بالحكومة الرّوسيّة وتابعٌ لوزارة الصّحّة الرّوسيّة ومقرّه العاصمة موسكو.[11] واللّقاح الأمريكيّ طوّرته شركة مودِرنا (Moderna) الأمريكيّة ومقرّها ماساتشوستس في الولايات المتّحدة.[12] واللّقاح الأخير الأمريكيّ-الألمانيّ طوّرته شركة فايزر (Pfizer) الأمريكيّة، بالتّعاون مع شركة بيو إن تك (BioNTech) الألمانيّة.[13] وحين تطوّر شركاتٌ خاصّةٌ أو معامل حكومةٍ لقاحًا ضدّ مرضٍ ما، فليس الأمر بغريبٍ ولا مُستبعدٍ؛ لأنّ الشّركات والحكومات لديها معامل عملاقةٌ وأموالٌ ضخمةٌ وأجهزةٌ ومعدّاتٌ على أعلى وأحدث المستويات. أمّا أن يطوّر معهدٌ في جامعةٍ لقاحًا -وهو لا يملك مثلما تملك الحكومات أو الشّركات- فذاك أمرٌ يجعل لقاح أوكسفورد مميّزًا عنهم جمعيًا؛ فما فعله معهدٌ داخل جامعة أوكسفورد منفردًا، يساوي ما فعلته دولٌ كاملةٌ بوزاراتها وحكوماتها وشركاتها مجتمعاتٍ.
بين الأزهر وأوكسفورد
هذا المبلغ العظيم الّذي بلغته تلك الجامعة لن يتّضح أثره بشكلٍ جليٍّ إلّا إذا قارنّاها بغيرها، فـ «بضدّها تُعرف الأشياء» كما قال المتنبّي.
تشابه البدايات
تعتبر أوكسفورد هي أوّل جامعةٍ في العالم المتحدّث بالإنجليزيّة، لكن لا يُعلم تاريخٌ محدّدٌ لإنشائها، فقد بدأ التّدريس بها تقريبًا في حدود عام 1096 ميلاديًّا.[14] كذلك تعتبر جامعة الأزهر من أولى الجامعات في العالم المتحدّث بالعربيّة، بل هي أوّل جامعةٍ أُنشئت في مصر، أنشأها الفاطميّون عام 970 ميلاديًّا.[15] يمكن المقارنة بين الجامعتين ليس فقط لأنّهما متشابهتان في النّشأة، بل لأنّهما أيضًا أُنشئتا في بادئ الأمر كجامعاتٍ دينيّةٍ ثمّ تحولتا بعد ذلك إلى جامعاتٍ مدنيّةٍ. فجامعة الأزهر كانت جامعًا وكان التّدريس بها يتمّ داخل المسجد، وجامعة أوكسفورد كانت كنيسةً، ودُرّس الطّلّاب بها داخل أبنية الكنائس. تحديدًا في كنيسة العذراء وهي أوّل مباني الجامعة، حيث كانت تُقام بها الصّلوات، وتُلقى فيها المحاضرات والنّدوات، وتُقام فيها حفلات التّخرّج وتسليم الشّهادات للطّلّاب.
وحاش للّه أن نقارن بين الأزهر وأوكسفورد في النّشأة -سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ-؛ فجامعة الأزهر أُنشئت قبل جامعة أوكسفورد بأكثر من قرنٍ كاملٍ من الزّمان. ومائة سنةٍ ليست بالمدّة القليلة أبدًا في تاريخ بناء الأمم وتطوّر العلم، أضف إلى ذلك أنّه في الوقت الّذي لم تكن فيه مكتبةٌ واحدةٌ في جامعة أوكسفورد، كانت مكتبة القاهرة تحوي 2 مليون و600 ألف كتابٍ كما أورد المقدسيّ. بل لقد ظلّت أوكسفورد بعد ذلك لمدّة ثلاثة قرونٍ خاليةً من أيّ مكتباتٍ.
مكتبة الجامعة
لكن… وما أقبح ما بعد كلمة لكن، تدهور الأزهر وتراجع وتقدّمت أوكسفورد وازدهرت، فهذه المكتبة الّتي حوت أكثر من 2 ونصف مليون كتابٍ، دمّرها جنود صلاح الدّين الأيّوبيّ حين استولوا على القاهرة، وألقوا بهذه الكتب في الماء والبِرك، بل لقد اتّخذوا من جلودها أحذيةً يلبسونها، وتبدّلت حال الكتب، فبدل أن تعيَها العقول صارت تُلبس في الأقدام كالأحذية. وما أدراكم بحال أمّةٍ تضع الكتبَ تحت أقدمها بدلًا من وضعها فوق رؤوسها. وما تبقّى من هذه الكتب دون دمارٍ أو حرقٍ أو إلقاءٍ في الماء، تركوه حتّى غطّاه التّراب والعفن، حتّى صارت تلالًا من كتبٍ. قال الدّكتور زكي محمّد حسن: «وقد استولى الجند والأمراء على نفائس ما في خزانة الكتب، فتفرّقت أكثر محتوياتها، وكان بعض العبيد والإماء يتّخذون من جلودها أمدسةً يلبسونها في أرجلهم».[16] وقد منع صلاح الدّين إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، واستمرّت الصّلاة والتّدريس معطّلين في الأزهر لمدّة قرنٍ كاملٍ من الزّمان حتّى أعادهما الظّاهر بيبرس. وقد ذكر أبو شامة المقدسيّ في كتابه عن بيع جنود صلاح الدّين للأخضر واليابس ممّا خلّفته الدّولة الفاطميّة في مصر، وقال:
«ومن جملَة ما باعوا خزانَة الكتب وكانَت من عجائب الدُّنْيا ويُقال إنَّه لم يكن فِي جَمِيع بِلاد الإسْلام دار كتبٍ أعظم من الدّار الَّتِي بِالقاهِرَةِ فِي القصر، ومن عجائبها أنّه كانَ بها ألفٌ ومائتان وعِشْرُونَ نُسْخَةً بتاريخ الطَّبَرِيّ ويُقال إنَّها كانَت تحتوي على ألفي ألفٍ وستّ مائة ألف كتابٍ.»[17]
العلوم الطبيعية
في الوقت الّذي بدأت فيه جامعة أوكسفورد تتبنّى العلم الحديث، فهذا روجر بيكون (Roger Bacon) أحد مؤسّسي المنهج العلميّ الّذي دعا إلى البناء على علوم المسلمين واستخدام علم الفلك والرّياضيّات والفلسفة وعلم البصريّات الإسلاميّ، وأشار كثيرًا في كتبه إلى ابن الهيثم، والفارابيّ والخوارزميّ وعالم الرّياضيّات أحمد بن يوسف البغداديّ، وغيرهم، وهو خرّيج أوكسفورد؛[18] كانت علوم المسلمين قد اضمحلّت وتراجعت. فحين عُيّن أحمد باشا كور واليًا جديدًا على مصر، لم يرَ فيها علمًا ولا معرفةً، فذهب إلى شيخ الأزهر الشّيخ عبد اللّه الشّبراويّ وقال له: كنّا نعلم في ديارنا أنّ مصر منبع العلوم والفضائل، وكنت متشوّقًا غاية الشّوق إلى المجيء إليها، ولم أجد عندكم منها شيئًا، وغاية تحصيلكم الفقه والتّوحيد والنّحو والصّرف. فأجابه شيخ الأزهر: إنّ غالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيءٍ من العلوم الرّياضيّة إلّا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث. ثمّ معرفة ذلك من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكلّ. وهذه العلوم تحتاج إلى شروطٍ وآلاتٍ وصناعاتٍ، وأهل الأزهر بخلاف ذلك، غالبهم فقراء وأخلاطٌ مجتمعيّةٌ من القرى والآفاق، فيندر فيهم القابليّة لذلك. فسأله الباشا: وأين هذا البعض؟ فدلّه شيخ الأزهر على رجلٍ يُدعى حسن الجبرتيّ، كان له نصيبٌ وافرٌ من تلك العلوم والمعارف. فقابله الباشا، وسأله عنها فوجده مُلمًّا بها عالِمًا بتفاصيلها، وبدأ يتردّد عليه كلّ أسبوعٍ مرّتين، حتّى استعصت على الباشا ذات يومٍ مسألةٌ حسابيّةٌ، فأجابه عنها الشّيخ حسن الجبرتيّ، فلمّا انجلى وجهُها على مرآة عقله، كاد يطير الباشا فرحًا وحلف أن يقبّل يده. وكان شيخ الأزهر كلّما قابل الشّيخ حسن الجبرتيّ يقول له: «سترك اللّه كما سترتنا عند هذا الباشا، فلولا وجودك كنّا جميعًا عنده حميرًا».[19]
وربّما من المثير للسّخرية بل المثير للحزن والأسف، أنّ عبدالرحمن الجبرتيّ -ابن الشّيخ حسن الجبرتيّ- يحكي بعد ذلك في تاريخه عن الحملة الفرنسيّة حين دخل نابليون مصرَ وجنودُه، ووقت هجومه بأسلحته ومدافعه ليدقّ بها الحصون المصريّة، كان العلماء والفقهاء في الأزهر يقرأون صحيح البخاريّ ليهزم اللّه نابليون وجنده. يقول الجبرتيّ: وقد كان العلماء عند توجّه مراد بك يجتمعون بالأزهر كلّ يومٍ، ويقرأون البخاريّ وغيره من الدّعوات، وكذلك مشايخ الأحمديّة والرّفاعيّة وغيرهم من الطّوائف يعملون لهم مجالس بالأزهر، وكذلك أطفال المكاتب، ويذكرون الاسم اللّطيف وغيره من الأسماء.[20]
استخدام الطباعة
بدأت أوكسفورد في إنشاء مكتبةٍ هي الآن ثاني أكبر مكتبةٍ في بريطانيا، وتضمّ حوالي 12 مليون كتابٍ، في حين استعمل بعض المصريّين جلود الكتب ليلبسوها أحذيةً في أرجلهم. بدأت أوكسفورد تنادي بتدريس العلوم الإسلاميّة والحساب والفلك، في حين كان شيوخ الأزهر في هذه العلوم حميرًا -على حدّ وصف شيخ الأزهر نفسه-. كما استعملت أوكسفورد الطّباعةَ بعد سنتين فقط من إدخال الطّابعات إلى إنجلترا على يد ويليام كاكستون (William Caxton). بل لم تكتف أوكسفورد باستخدام الطّابعات في طباعة كتبها الدّينيّة والعلميّة، وإنّما أرادت أن تمتلك طابعةً خاصّةً بها ليكون لها حقُّ النّشر بذاتها، وقد حصلت عليه بالفعل.[21] في هذا التّوقيت حيث حاربت أوكسفورد في معركةٍ ضاريةٍ ليكون لها الحقّ في الطّباعة الذّاتيّة، كانت الطّباعة قد حُرِّمت في البلاد الإسلاميّة، فلم توجد طابعةٌ في مصر إلّا بعد 350 سنةً من وجود الطّابعة في أوكسفورد.[22] وعلى العكس من محاربة أوكسفورد ليكون لها الحقّ في طباعتها الخاصّة، وأنّ أوّل ما طبعته كانت نصوصًا مقدّسةً؛ حارب علماء الأزهر طباعة القرآن الكريم، وكانت حججهم في ذلك أنّ الحبر المستخدم في الطّباعة ليس طاهرًا وأنّ آيات القرآن لا يجوز أن تُدقّ بالحديد.
إصلاح التعليم
وفي الوقت الّذي بدأت فيه أوكسفورد في تدريس العلوم الطّبيعيّة، كالرّياضيّات والفيزياء والفلك والطّبّ، والفلسفة والقانون واللّغات وغيرها، من منتصف القرن الثّالث عشر؛ وبعد أن استمرّت دراسة تلك العلوم في أوكسفورد لمدّة 600 سنةٍ، جاء سؤالٌ لشيخ الأزهر عام 1902 يسألونه: ما قولكم – رضي اللّه عنكم – هل يجوز تعلّم المسلمين العلوم الرّياضيّة مثل الحساب والهندسة والجغرافيا والعلوم الطّبيعيّة؟[23]
بعد ستّة قرونٍ كاملةٍ من تدريس تلك العلوم في جامعة أوكسفورد، كان السّؤال الّذي يؤرّق النّاس في الأزهر: هل يجوز دراسة هذه العلوم أم لا؟ وحين أراد الأستاذ الإمام محمّد عبده إصلاح الأزهر، وإضافة تلك العلوم الحديثة إلى المناهج، انقلب عليه طلبة الأزهر أنفسهم وشيوخ الأزهر محاربين تلك العلوم، على رأسهم الشّيخ سليم البشريّ هو وكلّ المحاربين للإصلاح، وأخذوا ينشرون في الجرائد ويحاربون العلوم الحديثة قائلين إنّه لا حاجة للأزهر بهذه العلوم، ولا نفع للطّلاب منها.[24] حتّى أُلغيت دراسة تلك العلوم بالفعل من الأزهر بعدما أدخلها الإمام محمّد عبده. لتعود بعد ذلك مرّةً أخرى، بعدما جُرّ الأزهر إلى تدريسها جرًّا.
ميزانية الجامعة
أمّا فيما يخصّ ميزانيّة كلّ جامعةٍ منهما، فقد وصلت ميزانيّة جامعة أوكسفورد في العام الماضي إلى 2.5 مليار جنيهٍ إسترلينيٍّ. كما طوّرت الجامعة نظام الوقف لديها حتّى وصل مقدار ما لديها من وقفٍ إلى 6 مليار جنيهٍ إسترلينيٍّ.[25] بينما وصلت ميزانيّة الأزهر إلى 2.5 مليار جنيهٍ مصريٍّ تقريبًا.[26] أي أنّ ما تملكه جامعة أوكسفورد يكفي لإنشاء 71 جامعةً مثل جامعة الأزهر. غير أنّ ميزانيّة أوكسفورد لا تأخذها من الدّولة كما هي الحال مع جامعة الأزهر، وإنّما تدير جامعة أوكسفورد نفسَها بنفسِها، وتصنع مالَها بذاتها؛ ذلك أنّه كما قالوا: «من لا يملك قوته لا يملك حرّيّته.» فإنّ أوكسفورد لا تنتظر مِنّةً أو مِنحةً من الدّولة عليها، ولو انتظرت لكانت حرّيّة العلم فيها محدودةً، فسيكون للدّولة عليها يدٌ وسلطانٌ، لذلك تتمتّع أوكسفورد باستقلالٍ تامٍّ عن الحكومة البريطانيّة، استقلالٍ ماليٍّ وسياسيٍّ وإداريٍّ. في حين لا تملك ذلك جامعة الأزهر. لا تملك حرّيتها ولا قرارها؛ ذاك أنّها لا تملك قوتها، فهي تدور مع الدّولة حيث دارت ومع السّياسة حيث شاءت.
تعليم البنات
وإذا كان حديثنا عن لقاح أوكسفورد، وكلّ من ذكرناهم كانوا نساءً، فأوّل مَن عَمِلَ على تصميم اللّقاح كُنّ نساءً في جامعة أوكسفورد، وأوّل متطوّعةٍ تلقّت اللّقاح كانت امرأةً باحثةً في أوكسفورد، فقد كان تعليم البنات من المعارك الّتي خاضتها البشريّة، فقد سُمِح للنّساء بالالتحاق بكليّة الطّبّ بجامعة أوكسفورد عام 1916.[27] بينما سُمح للنّساء بدراسة الطّبّ في الأزهر عام 1964، أي بعد ألف سنةٍ كاملةٍ من إنشاء جامعة الأزهر.[28]

والسّؤال الّذي سأترك إجابته للقارئ، إذا وصلت النّساء الآن إلى هذا الشّأن العظيم من العلم، ومن الإنتاج القياسيّ للّقاح في يومين اثنين، ليكون به -حرفيًّا- إنقاذ البشريّة، إذا كانت النّساء هُنّ مَن شاركن بشكلٍ رئيسٍ في إنتاج اللّقاح، وكتابة أوّل كودٍ برمجيٍّ في التّاريخ، وكتابة الكود الّذي أوصل الإنسان إلى القمر، إذا كانت النّساء وصلن إلى الفوز بجائزة نوبل مرّتين وفي مجالين مختلفين، كلّ هذا فعلته النّساء بعد أقلّ من قرنٍ واحدٍ فقط من السّماح لهنّ بالتّعليم، فما عساهنّ فاعلاتٍ لو سُمِح لهنّ بالدّراسة منذ عشرة قرونٍ؟ ماذا عساهنّ فاعلاتٍ لولا العقليّة الرّجعيّة الّتي عملت على تجهيل المرأة عشرة قرونٍ كاملةٍ؟
سأترك الجواب لك عزيزي القارئ لتقول هل ساهمت تلك الجامعات في تقدّمنا أم في تأخّرنا؟ هل ساهمت في تعليم المجتمع أم تجهيله؟
القصة الحقيقية
لذلك فإنّ القصّة الكاملة وراء إنتاج اللّقاح، لا تبدأ من العام الماضي، ولا حتّى منذ 25 سنةً. وإنّما بدأت حين أدخلت أوكسفورد الطّباعة، وبنت مكتبتها الخاصّة، ودرّست العلوم الحديثة، وانتزعت استقلالها عن الدّولة، وأدارت نفسها ماليًّا. فأوكسفورد الّتي تصل ميزانيّتها الآن إلى 8.5 مليار جنيهٍ إسترلينيٍّ، كانت قد أفلست عام 1280 وكانت تقترض الأموال من النّاس.[29] القصّة تبدأ من روجر بيكون الّذي دعا إلى المنهج العلميّ الحديث، تبدأ من روبرت هوك (Robert Hooke) الّذي درس في أوكسفورد، وروبرت بويل (Robert Boyle) وغيرهم. هؤلاء العظام الّذين أسّسوا النّادي الفلسفيّ في أوكسفورد، مجتمعين بچون ويلكنز (John Wilkins)، حيث كان هذا النّادي الطّلابيّ نواةً لإنشاء الجمعيّة الملكيّة البريطانيّة، أحد أعظم الجمعيّات العلميّة في العالم، بل هي أوّل جمعيّةٍ علميّةٍ عرفها التّاريخ.[30] تبدأ قصّة لقاح أوكسفورد من مئات السّنين، حاولت فيها الجامعة أن تكون مكانًا للتّقدّم وللعلم وللحرّيّة وللاستقلال، وليست وليدة يومٍ أو سنةٍ أو عقدٍ أو قرنٍ. القصّة كُتبت فصولها خلال قرونٍ من التّجديد والتّطوير حتّى احتلّت تلك المكانة العالية.