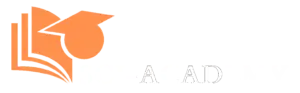إن قضية «حرية الإرادة» تُعد من أعظم الأسئلة الفلسفية التي شغلت العقل البشري منذ فجر التاريخ، ولا تزال تُشعل نار النقاشات العميقة بين الفلاسفة والمفكرين والعلماء حتى عصرنا الحاضر، ولا يبدو أنها ستخبو أو تفقد مكانتها كواحدة من أعقد الإشكاليات التي تواجه الفلسفة والعلم على حد سواء. وفي هذا السياق، لا يسعى هذا المقال إلى تأييد رأي أو تفنيد آخر في مسألة حرية الإرادة، ولا يهدف إلى أن يكون سيفًا يفصل بين الحق والباطل، أو ميزانًا يرجح كفة فكرة على أخرى. بل ينصب تركيزه على استكشاف تأثير القول بالجبر وإنكار حرية الإرادة على سلوك الإنسان وأخلاقياته، سواء في تعامله مع ذاته أو مع الآخرين.
إن النقاشات التي تدور في القرن الحادي والعشرين حول هذا الموضوع ليست بالجديدة، بل هي امتداد لما شهده القرن التاسع عشر من جدالات فكرية حامية. ففي ذاك العصر، سعى علماء الفيزيولوجيا إلى تفسير الإدراك البشري واتخاذ الإنسان لقراراته على أنهما مجرد عمليات مادية بحتة تحدث في الدماغ، وذهبوا إلى حد القول إن فكرة الإرادة الحرة ليست سوى «وهم» خلقه العقل البشري. وكان العالم الطبيعي الألماني-السويسري كارل فوغت (Carl Vogt) من أبرز مروّجي هذه الرؤية، إذ صرّح بما أثار جدلاً واسعًا قائلاً: «الدماغ البشري يُنتج الأفكار كما تُنتج الكلى البول». ولا تزال جملته الشهيرة تلك يكررها أصحاب هذه النظرة حتى يومنا هذا. ففي عام 1852 أطلق كارل فوغت تصريحاته المثيرة التي أثارت زوبعة فكرية، مؤكداً أنّ:
الإرادة الحرة محض وهم لا وجود له، ومع غيابها، تسقط عنا المسؤولية الأخلاقية وتنهار أسس النظام القضائي الجنائي، إلا أن الله وحده يعلم من يسعى لفرضها علينا. نحن، في كل لحظة، لسنا المتحكمين في أنفسنا ولا عقولنا ولا قدراتنا الفكرية، تمامًا كما أننا لا نملك السيطرة على إفراز الكلى للبول من عدمه. فالكيان الحي عاجز عن التحكم بذاته؛ إذ تحكمه قوانين تكوينه المادي الصرف. وما يدور في أذهاننا في لحظةٍ ما، إنما هو انعكاسٌ لحالتنا النفسية وتكوين أدمغتنا في تلك اللحظة.1
لكن، وكما يحدث دائمًا، لم تمرّ تلك التصريحات دون أن تواجه نقدًا حادًا. فقد كان العالم التشريحي والطبيب النمساوي جوزيف هايرتل (Joseph Hyrtl) من أوائل المعارضين لهذه الفكرة، حيث أكد أن «العلم الحديث لم يقدّم أي دليل قاطع يُثبت مثل هذه المزاعم». ولم يغفل هايرتل الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في تضخيم الآراء المتطرفة وإضفاء طابع الإثارة عليها.
أما عالم الفيزيولوجيا الألماني البارز إميل دو بوا ريمون (Emil du Bois-Reymond)، فقد تجاوز النقد المباشر ليقدّم رؤية أكثر شمولاً. ففي عام 1872، أعلن عبارته الشهيرة باللاتينية «Ignoramus et ignorabimus» (نحن نجهل وسوف نظل في جهالة أبدية) فيما يخص كيفية نشوء الأفكار من المادة. وأضاف أن أصل الوعي والإرادة الحرة سيبقيان في قائمة الألغاز التي يعجز العلم عن حلّها.2
وبعد مرور قرن ونصف من الزمن، أظهر باحثون أخرون كيف أن وسائل الإعلام أساءت تقديم تجارب بنجامين ليبت (Benjamin Libet) الشهيرة، حيث وصفتها وسائل الإعلام وبعض الباحثين بأنها تشكّل دحضًا قاطعًا لفكرة الإرادة الحرة. ولكن المفارقة تكمن في أن بنجامين ليبت نفسه، الذي كان المشرف على هذه التجارب، لم يُقرّ أبدًا بمثل هذا الاستنتاج! بل على العكس، أوضح هو وزملاؤه أن الطاقة والقوى العصبية الموجودة في الدماغ لا يمكن اعتبارها السبب الوحيد الذي يؤدي إلى اتخاد الإنسان لقراره. فهنالك، بلا ريب، عملية أعمق وأدق، قد تكون واعية أو غير واعية، تُسهم في اتخاذ القرار النهائي وقيام الإنسان بالفعل.3
ولعلنا نفرد مقالًا قريبًا للغوص في أعماق تلك الادعاءات التي كررها بعض العلماء والباحثين ووسائل الإعلام بخصوص تجارب بنجامين ليبت وتجارب أخرى في علم الأعصاب. إذ عمد البعض – سواء عن قصد أو عن سوء قصد – إلى تحريف النتائج العلمية وتطويعها لخدمة أفكارهم التي تنفي وجود حرية الإرادة. وسنسعى في هذا المقال المرتقب إلى كشف زيف تلك الادعاءات، ووضع الحقائق في نصابها العلمي الصحيح، بعيدًا عن المبالغات والتفسيرات المتعسفة التي لا تخدم سوى إرباك النقاش الفلسفي والعلمي في هذا المجال العميق والمعقّد.
إن هذا التحريف للحقائق العلمية لن يفيد العلم ولا الناس، ولن يخدم أيَّ غاية سوى الإضرار بالسلوك البشري، كما سنوضح في هذا المقال. بل إن مثل هذه الأفعال تسهم في زيادة الجهل باسم العلم، وما أقبحه من فعل! أن يُستخدم العلم، الذي هو في جوهره أنبل وأشرف ما ابتغاه الإنسان لمعرفة الحقائق، كأداة لتمرير الجهل، الذي يُعد في أصله أبشع وأدنى ما يمكن أن يعتري المجتمعات. فلا أسوأ من أن تُستغل راية الحقيقة العلمية لخدمة أغراض مشبوهة تُضلل العقل، وتُفسد السلوك، وتُزعزع أُسس الأخلاق.
ولكن، ماذا أريد أن أقول في هذا المقال؟ إنني لن أتحدث عن وجود حرية الإرادة من عدمها، ولن أتناول الأخبار والادعاءات التي انتشرت مؤخرًا وتم الترويج لها على ألسنة العلماء والفلاسفة. بل أقول: فلنفترض – على سبيل الجدل – أن الإرادة الحرة لا وجود لها، وأن الإنسان ليس سوى كيان مجبر مسيّر، بلا اختيار أو إرادة. ولنمضِ أبعد من ذلك، ولنقبل جدلًا أن ما يُقال عن أن علم الأعصاب قد نفى وجود حرية الإرادة هو كلام صحيح تمامًا.
هب أن كل ذلك حق. فهل انتشار هذه الفكرة بين الناس، أعني فكرة أن الإنسان مجبر ولا إرادة له ولا اختيار، وترويجها والدفاع عنها وتكرارها على الأسماع والأبصار، هل له أثر إيجابي على سلوك الفرد والمجتمع؟ أم أن هذه الفكرة، إذا ما ترسخت وانتشرت، تحمل في طياتها أثرًا مدمرًا على أخلاقيات الإنسان وسلوكه تجاه نفسه وتجاه الآخرين؟
إن هذا هو جوهر ما أسعى إلى مناقشته. فبينما قد تكون الأسئلة الفلسفية حول حرية الإرادة شائكة ومعقدة، فإن أثر هذه الفكرة – حين تُروّج كحقيقة يقينية – على القيم الإنسانية، والأخلاق، والتصرفات اليومية، لهو موضوع يستحق التأمل والنقاش الجاد. فإذا اعتقد الإنسان أنه مجرد آلة تحركها قوانين مادية، فما الذي سيبقى من دوافعه الأخلاقية، وشعوره بالمسؤولية، وإيمانه بأهمية العدل والحق؟
الإرادة الحرة وأثرها على الأخلاق: بين جدل الماضي وتجارب الحاضر
يرجع النقاش حول وجود الإرادة الحرة إلى زمن بعيد، حيث طالما كان هذا الموضوع محور جدل عميق بين الفلاسفة وعلماء الكلام، غير أن هذا الجدل أخذ في عصرنا الراهن أبعادًا غير مسبوقة. فقد انتشرت فكرة إنكار وجود الإرادة الحرة كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام العامة، مما جعلها تتجاوز الأوساط الأكاديمية لتصبح موضوعًا للنقاش العام. وترافق ذلك مع العديد من التجارب الحديثة التي سعت لقياس أثر الاعتقاد بعدم وجود الإرادة الحرة على السلوك البشري.
أحد أبرز هذه الدراسات أُجريت في الولايات المتحدة وكندا، حيث عمد الباحثون إلى قياس تأثير قراءة النصوص المؤيدة لفكرة الحتمية الفيزيائية والبيولوجية – والتي تقول إن الإنسان لا خيار له ولا إرادة – على أخلاقيات الأفراد. فكانت النتائج صادمة: الأشخاص الذين قرأوا عبارات تؤكد إنكار الإرادة الحرة كانوا أكثر غشًا وخداعًا في الاختبارات من أولئك الذين قرأوا نصوصًا محايدة لا علاقة لها بهذا الموضوع.
في واحدة من تلك التجارب، قام الباحثون باختيار ثلاثين طالبًا جامعيًا وقسموهم إلى مجموعتين. طلبوا من المجموعة الأولى قراءة فقرة من كتاب «The Astonishing Hypothesis» للعالم الإنجليزي الحائز على جائزة نوبل فرانسيس كريك (Francis Crick)، وهي فقرة ينفي فيها كريك وجود حرية الإرادة. يقول كريك في هذه الفقرة: «إن الإرادة الحرة ليست سوى وهم يعتقده البشر، وإن الشعور بالحرية الذي نحسه ليس سوى أثر جانبي لنشاط الدماغ وبنيته». أما المجموعة الثانية، فقد قرأت فقرة أخرى من نفس الكتاب تتناول موضوع الوعي البشري، لكنها لا تحتوي أي إشارة إلى حرية الإرادة.
ثم خضع كلا الفريقين لاختبار رياضيات بسيط على جهاز الكمبيوتر، حيث أخبرهم الباحثون أن الجهاز يعاني خللًا يجعله يعرض الإجابات تلقائيًا، إلا إذا ضغط المشارك على زر معين في لوحة المفاتيح عند ظهور السؤال. طُلب من المشاركين أن يضغطوا على الزر كي تُخفى الإجابات ويجيبوا بصدق وأمانة. كانت هذه الحيلة جزءًا من تصميم التجربة لرصد سلوك الغش.
وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التي قرأت النص المؤيد لإنكار الإرادة الحرة كانت أقل التزامًا بالأمانة، حيث تجنب كثيرون الضغط على الزر، مما أتاح لهم رؤية الإجابات وبالتالي الغش في الاختبار. أما المجموعة الأخرى، التي قرأت نصًا محايدًا، فقد أظهرت سلوكًا أكثر نزاهة.4

هذا يقودنا إلى سؤال محوري: هل مجرد الامتناع عن فعل معين (مثل عدم الضغط على زر الكمبيوتر) يمكن اعتباره سلوكًا لا أخلاقيًا؟ إن هذا التساؤل يُعيدنا إلى الخلاف الفكري القديم بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم من علماء المعتزلة. فقد رأى أبو هاشم أن المرء قد يستحق الذم لعدم قيامه بفعل معين، بينما رأى آخرون أن العدم لا يمكن أن يكون أساسًا للتحسين أو التقبيح. فكيف يمكن أن يكون العدم، وهو في جوهره «لا شيء»، سببًا لمدحٍ أو ذم؟
على كل حال، نترك الخلاف الذي وقع بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، ونعود إلى التجارب الحديثة التي أجراها الباحثون. في محاولة لتجنب الإشكال الذي قد يُثار بشأن التجربة الأولى، قرر الباحثون إجراء تجربة ثانية تهدف إلى التأكد من أن نتائجهم ليست بسبب الكسل أو التراخي، بل بسبب تأثير النصوص التي قرأها المشاركون على سلوكهم الأخلاقي بشكل مباشر.
التجربة الثانية: سلوك الغش عبر القيام بالفعل
لتحقيق ذلك، قام الباحثون بتقسيم ما يقرب من 120 مشاركًا إلى خمس مجموعات. ثلاث من هذه المجموعات وُضعت في ظروف تسمح لهم بالغش، بينما وُضعت المجموعتان الباقيتان في ظروف لا تسمح بالغش. أما المجموعات الثلاث التي كانت في ظروف الغش، فقد قُسّمت بدورها إلى:
- مجموعة قرأت نصوصًا تنفي حرية الإرادة، مثل العبارة: «الاعتقاد بوجود حرية الإرادة يتعارض مع حقيقة أن الكون تحكمه قوانين فيزيائية وعلمية».
- مجموعة قرأت نصوصًا تؤيد حرية الإرادة، مثل العبارة: «أنا أستطيع أن أتغلب على العوامل البيئية والجينية التي ربما تتحكم في تصرفاتي».
- مجموعة قرأت نصوصًا محايدة لا علاقة لها بحرية الإرادة.
بعد ذلك، أخبر المراقبون جميع المشاركين أن لكل إجابة صحيحة على الأسئلة التي يجيبون عنها سيحصلون على دولار واحد. ثم افتعل المراقبون موقفًا، وزعموا أن لديهم اجتماعًا هامًا، مما يضطرهم إلى مغادرة قاعة الامتحان وترك الطلبة دون مراقبة. وأُبلغ الطلبة أن عليهم ألا يغشوا وأن يكونوا أمناء في تقدير عدد الإجابات الصحيحة التي أجابوا عنها، ثم يأخذوا بأنفسهم المال الذي يستحقونه بناءً على إجاباتهم الصحيحة.
ما أظهرته نتائج التجربة كان مثيرًا للاهتمام ومثيرًا للقلق في آن واحد:
- المجموعة التي قرأت النصوص التي تنفي حرية الإرادة زعمت أنها أجابت إجابات صحيحة أكثر مما فعلت في الواقع، وأخذت أموالًا أكثر من المجموعات الأخرى.
- أما المجموعة التي قرأت نصوصًا تؤيد حرية الإرادة، فقد أظهرت سلوكًا أكثر أمانة، وكانت أقل المجموعات غشًا، حيث أخذت أموالًا تتناسب مع متوسط الإجابات الصحيحة للمجموعات الأخرى.
هذا الاختلاف الواضح في السلوك الأخلاقي بين المجموعتين يعزز فكرة أن الإيمان بحرية الإرادة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية الفردية. أما إنكار حرية الإرادة، فإنه يبدو وكأنه يُضعف الإحساس بالمسؤولية ويشجع على سلوكيات غير أخلاقية.5
باختصار، كشفت التجربتان عن أثر إنكار حرية الإرادة على السلوك البشري. في التجربة الأولى، أظهر المشاركون الذين قرأوا نصوصًا تنفي الإرادة الحرة ميلًا أكبر للغش مقارنة بغيرهم، ما أشار إلى علاقة مقلقة بين هذه الفكرة وسلوكيات غير أخلاقية. أما التجربة الثانية، فقد كانت أكثر أهمية ودقة، إذ تضمنت أفعالًا مباشرة في ظروف تسمح بالغش، مما أزال أي شكوك حول احتمال أن يكون السلوك في التجربة الأولى ناجمًا عن الكسل أو عدم الفعل. النتائج في التجربة الثانية أكدت بوضوح أن المشاركين الذين تعرضوا لنصوص تنكر حرية الإرادة زعموا تحقيق إنجازات أعلى واستولوا على أموال أكثر مما يستحقون، ما يبرز التأثير المدمر لهذه الفكرة على النزاهة والأمانة بشكل عملي وملموس.
تأثير نفي حرية الإرادة على التصرفات تجاه الآخرين
وإن كانت التجارب الأولى قد ركزت على السلوك الفردي، حيث ظهر تأثير إنكار حرية الإرادة في تصرفات المشاركين تجاه أنفسهم – كالغش في امتحان الرياضيات في التجربة الأولى، أو الادعاء بتحقيق إنجازات غير حقيقية للحصول على أموال أكثر في التجربة الثانية – إلا أن تلك التجارب لم تتجاوز حدود الأفراد، إذ لم يُلحِق المشاركون أذى بغيرهم. فقد بقي الضرر محصورًا في إطار علاقتهم بأنفسهم. ولكن، ماذا عن تأثير هذا الاعتقاد حينما يتسع نطاقه ليشمل تعامل الإنسان مع الآخرين والمجتمع؟
لمعالجة هذا السؤال، قرر باحثون آخرون توسيع دائرة التجربة، مُصممين اختبارًا يقيس أثر الاعتقاد بعدم وجود حرية الإرادة على سلوك الإنسان تجاه غيره. فقاموا بتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: قُدمت للمجموعة الأولى نصوصٌ تنفي حرية الإرادة، مثل: «لقد أثبت العلم أن الإرادة الحرة مجرد وهم»، أو: «الأفعال البشرية محكومة تمامًا بعوامل بيئية ووراثية». أما المجموعة الثانية، فقد قرأت نصوصًا تؤكد وجود حرية الإرادة، بينما قُدمت للمجموعة الثالثة نصوصٌ عامة لا علاقة لها بهذا الموضوع.
بعد ذلك، عرض الباحثون على جميع المشاركين ستة سيناريوهات افتراضية تُظهر أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة، مثل مشردٍ بلا مأوى يحتاج إلى مال، أو زميلٍ يطلب استعارة الهاتف لإجراء مكالمة ضرورية. ثم طلبوا من المشاركين أن يقيّموا مدى رغبتهم واستعدادهم لتقديم المساعدة في تلك المواقف.
فجاءت النتائج كاشفةً وصادمةً: المشاركون الذين قرأوا نصوصًا تنفي حرية الإرادة كانوا أقل ميلًا بكثير إلى مساعدة الآخرين في هذه السيناريوهات، مقارنةً بمن قرأوا نصوصًا تؤيد الإرادة الحرة أو نصوصًا عامة. وهكذا، أظهرت الدراسة أن الاعتقاد بعدم وجود حرية الإرادة لا يقتصر على التأثير في سلوك الفرد تجاه نفسه، بل يمتد ليؤثر على طريقة تعامله مع الآخرين، مهددًا أسس التعاون والتعاطف الإنساني.
من الأقوال إلى الأفعال
لم تتوقف تجارب الباحثين عند حدود التصريحات النظرية أو الإجابات اللفظية تجاه السيناريوهات الافتراضية، بل سعوا إلى تجاوز ذلك لاختبار تأثير إنكار حرية الإرادة على السلوك الحقيقي في مواقف عملية. فقد أدركوا أن الإنسان قد يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر، وكما جاء في المثل العربي الشهير «قَطَعتْ جَهِيزَةُ قولَ كُلِّ خطيب»، أرادوا أن تحسم الأفعالُ ما قد تُخفيه الأقوال.
ولهذا، صمم الباحثون تجربة جديدة أكثر واقعية وملموسة. أخبروا المشاركين بأن التجربة تهدف إلى دراسة العلاقة بين فهم اللغة وشخصية الإنسان، وطلبوا منهم الاستماع إلى برنامج إذاعي عشوائي وتقديم تقرير عما فهموه منه. لكن الحقيقة أن جميع المشاركين استمعوا إلى نفس البرنامج الإذاعي الذي أعدّه الباحثون مسبقًا، وتضمن قصة فتاة تُدعى كاتي بانكس (Katie Banks)، فقدت والديها في حادث سيارة وأصبحت مسؤولة عن رعاية إخوتها. وكانت القصة تصف حال كاتي ومعاناتها، حيث اضطرت إلى التخلي عن دراستها للبحث عن عمل يعينها على الوفاء بالتزاماتها العائلية، إلا إذا تمكن أحد ما من مساعدتها ماديًا لتستمر في الدراسة وتقوم برعاية إخوتها في آن واحد.
بعد انتهاء المشاركين من الاستماع إلى القصة، أُبلغوا أن التجربة قد انتهت وتم شكرهم على تعاونهم. لكن عند خروجهم، واجههم القائم على التجربة باقتراح عملي، وهو أنه إذا كانوا قد استمعوا إلى قصة كاتي ولديهم رغبة في مساعدتها بأي شكل، سواء بتقديم تبرع مالي أو مساعدة بسيطة مثل تغليف الرسائل لها، فيمكنهم كتابة عدد الساعات التي يودون تخصيصها أسبوعيًا لهذه المساعدة.
كانت النتائج صادمة: ٧٠٪ من المشاركين الذين قرأوا نصوصًا تنفي حرية الإرادة لم يُبدوا أي رغبة في مساعدة زميلتهم بأي شكل على الإطلاق. أما الثلاثين بالمئة الباقون الذين أبدوا رغبة في المساعدة، فقد كانت الساعات التي خصصوها أقل بكثير مقارنة بالمشاركين الذين يؤمنون بحرية الإرادة.6
من السلبية إلى العدوانية
في التجارب السابقة، ركز الباحثون على دراسة تأثير إنكار الإرادة الحرة على سلوك الفرد تجاه نفسه أو تجاه الآخرين في مواقف ذات طابع سلبي غير عدائي. ففي التجربة الأولى، أظهر المشاركون الذين أنكروا حرية الإرادة ميلاً إلى الغش في امتحان الرياضيات، حيث لم يتحملوا مسؤولية أفعالهم واعتمدوا على سلوك غير أخلاقي لتحقيق مكاسب شخصية. أما في التجربة الثانية، فقد استغلوا الموقف لصالحهم عندما زعموا كذبًا أنهم أجابوا إجابات صحيحة للحصول على أموال أكثر مما يستحقون، مما يعكس افتقارًا إلى الشعور بالمسؤولية تجاه القيم الأخلاقية.
وفي التجربة الثالثة، حين طُلب منهم تقييم استعدادهم لمساعدة الآخرين في مواقف افتراضية، كان رد فعلهم سلبيًا، حيث أعلنوا بألسنتهم أنهم لن يساعدوا الناس في المواقف التي وصفها الباحثون. وعندما انتقل الأمر إلى التجربة الرابعة، حيث تحولت الأقوال إلى أفعال في سياق عملي، لم يمدوا يد العون لزميلتهم التي كانت في موقف مأساوي بعد فقدان والديها واضطرارها إلى ترك الدراسة. هذه التجارب كشفت أن تأثير إنكار الإرادة الحرة تمثل في سلوكيات أنانية أو سلبية تجاه الآخرين، لكن دون أن تتحول تلك السلوكيات إلى عدوانية صريحة.
السؤال الذي تطرحه هذه النتائج هو: إذا كان إنكار الإرادة الحرة يدفع الإنسان إلى اتخاذ مواقف سلبية تجاه الآخرين أو التقاعس عن مساعدتهم، فهل يمكن أن يتطور ذلك إلى مواقف عدائية تدفعه إلى إيذاء الآخرين بشكل مباشر؟ أراد الباحثون اختبار هذه الفرضية في تجربة جديدة تستهدف كشف الجانب العدائي الذي قد يظهر نتيجة لإنكار الإرادة الحرة. كان الهدف هو الانتقال من قياس السلبية أو الامتناع عن المساعدة إلى اختبار مدى استعداد الشخص للإقدام على أفعال تحمل طابعًا انتقاميًا وعدائيًا تجاه الآخرين.
ولتبيّن الإجابة عن هذا السؤال، صمم الباحثون تجربة جديدة مليئة بالحيلة والإتقان. استُهلت التجربة بإخبار بعض المشاركين أن زملاءهم الذين شاركوا معهم في الجلسات السابقة قد رفضوا العمل معهم أو اختيارهم كأعضاء في مجموعاتهم. كلمات بسيطة ولكن وقعها كان شديدًا على المشاركين، إذ استُخدمت بعناية لإثارة شعور بالرفض والإقصاء لديهم، وهو شعور له تأثير عميق على النفس البشرية. لم يكتفِ الباحثون بذلك، بل قدموا للمشاركين مهمة بديلة في سياق يبدو طبيعيًا تمامًا، لكنه يحمل في طياته اختبارًا خفيًا لنواياهم. قالوا لهم: «بما أن زملاءكم لا يرغبون في العمل معكم، لدينا لكم مهمة بسيطة، وهي إعداد الطعام لهؤلاء الزملاء.»
لكن المهمة لم تكن مجرد تحضير طعام عادي. قدم الباحثون للمشاركين خيارًا مفتوحًا لإضافة صلصة حارة للطعام الذي سيقدمونه لزملائهم، مع التأكيد على أن هؤلاء الزملاء قد عبروا بوضوح عن كراهيتهم الشديدة للطعام الحار. هنا يكمن جوهر التجربة، حيث كان مقدار الصلصة الحارة المضافة للطعام بمثابة مقياس خفي لمستوى العدوانية والرغبة في الانتقام لدى المشاركين.
جاءت النتائج صادمة وناطقة بوضوح. المشاركون الذين قرأوا عبارات تنكر حرية الإرادة، وأُثِّر على قناعاتهم لتبني فكرة أن أفعالهم محددة مسبقًا بالجينات والظروف البيئية، أظهروا مستويات أعلى من العدوانية. هؤلاء أضافوا كميات كبيرة من الصلصة الحارة مقارنة بالمشاركين الذين تم تعزيز إيمانهم بحرية الإرادة، على الرغم من علمهم أن زملاءهم يكرهون الطعام الحار. بدا وكأن شعورهم بالرفض الذي أُثير عمدًا في بداية التجربة قد دفعهم إلى استغلال هذه الفرصة للتعبير عن نزعات انتقامية واضحة.7
لكن هذا ليس كل شيء؛ التجربة أظهرت أبعادًا أعمق عن العلاقة بين الإيمان بحرية الإرادة وضبط النفس. أولئك الذين آمنوا بحرية الإرادة أظهروا قدرة واضحة على كبح رغبتهم في الانتقام، حتى بعد تعرضهم لشعور الرفض ذاته. بدا أن قناعاتهم بأنهم أسياد أفعالهم وأنهم يتحملون مسؤولية خياراتهم كانت كافية لإبقاء نزعاتهم العدوانية تحت السيطرة، مما جعلهم أكثر تحضرًا واتزانًا في تصرفاتهم.

تُبرز هذه التجربة حقيقة لا لبس فيها: الإيمان بحرية الإرادة ليس مجرد فكرة فلسفية تجريدية، بل هو عنصر جوهري في تشكيل سلوك الإنسان. حين يشعر الفرد بأنه مسؤول عن قراراته، يصبح أكثر ميلًا لضبط نفسه، حتى في أصعب الظروف. أما إنكار حرية الإرادة، فإنه يفتح الباب أمام الاستسلام لدوافع آنية وغير متحضرة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للتصرف بسلبية أو بعدوانية تجاه الآخرين.
أما وقد ركزت الدراسات السابقة على سلوك الإنسان وتصرفاته، سواء تجاه نفسه أو الآخرين، مستكشفةً تأثير الإيمان بحرية الإرادة على أخلاقياته وخياراته. لكن ما يثير الاهتمام حقًا هو دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Psychological Science»، لا تقتصر على تحليل السلوكيات الظاهرة، بل تتعمق في البنية العصبية للدماغ ذاته، كاشفةً كيف أن الاعتقاد بحرية الإرادة يمتد إلى أعمق مستويات العمليات العصبية المسؤولة عن اتخاذ القرارات والإرادة الحركية.
لكي يُقدِم الإنسان على أيِّ فعلٍ إرادي، لا بد أن يسبقه نشاطٌ عصبي في الدماغ يُهيّئه لاتخاذ قراره وتنفيذ الفعل. غير أن هذه الدراسة وجدت أن هذا النشاط العصبي، المسؤول عن توليد الإرادة والدفع نحو الفعل، يضعف بشكل ملحوظ عندما يتعرض الشخص لنصوص تُقوّض إيمانه بحرية الإرادة. بمعنى آخر، فإن مجرد قراءة أفكار تنفي الإرادة الحرة لا تؤثر فقط على القناعات الفكرية، بل تمتد لتُضعف قدرة الدماغ نفسه على الاستعداد للحركة واتخاذ القرار، مما يجعل الشخص أقل إرادة، وأقل دافعًا، وأقل استعدادًا للمبادرة بالأفعال. فليس الأمر مجرد تغيير في نظرة الإنسان لذاته، بل هو تغيير حرفي وفسيولوجي في طريقة عمل عقله، ونشاطه العصبي، واستعداده لاتخاذ القرارات والإقدام على الأفعال.8
ختامًا
ولا بد في النهاية من الإشارة إلى أن هذه التجارب أُجريت على عدد محدود من المشاركين، وفي ظروف مختبرية محددة، مما يجعل نتائجها محكومة بالسياقات والشروط التي تم فيها إجراء البحث. وكما هو شأن العلم دائمًا، تظل الاستنتاجات العلمية قيد النقاش والتطوير، ولا يمكن تعميمها خارج حدودها التجريبية دون تدقيق. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على قضية في غاية الأهمية تتعلق بتأثير الأفكار والمعتقدات التي يتم الترويج لها على السلوك الإنساني والمجتمع بأسره.
إن الكلمات التي يكتبها الفرد حين ينفي حرية الإرادة، سواء في مقالات أو أخبار أو أي وسيلة نشر أخرى، قد تحمل أثرًا أعمق مما يُتصور، ليس فقط على مستوى الفكر، بل على مستوى السلوكيات الشخصية والجماعية. ولذا، فإن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في إدراك التأثيرات البعيدة المدى لمثل هذه الأفكار على الأفراد والمجتمعات. كما أظهرت تلك التجارب، فإن مجرد التعرض لفكرة تنفي حرية الإرادة قد يدفع الإنسان إلى تبني سلوكيات قد تضر بنفسه وبالآخرين، وتُضعف الروابط الاجتماعية التي يقوم عليها أي مجتمع متماسك.
من حق الإنسان، بل من واجبه الفكري، أن يُعمل عقله في مسألة حرية الإرادة، وأن يصل إلى الاعتقاد الذي يقتنع به، سواء كان مؤمنًا بوجودها أو منكرًا لها. لكن عليه كذلك أن يدرك تبعات هذا الاعتقاد على من حوله، وأن يتحمل المسؤولية عن الآثار التي قد تترتب على نشر مثل هذه الأفكار. إن المجتمع لا يتشكل فقط من أفراد يؤمنون بما يريدون، بل يتشكل من شبكة من العلاقات والتأثيرات المتبادلة التي تجعل من كل كلمة أو فكرة مسؤولية تتجاوز صاحبها لتطال تأثيراتها الجميع. إن حرية التفكير حق، لكنها تأتي مقرونة بمسؤولية إدراك أثرها على رفاه المجتمع وتماسكه.